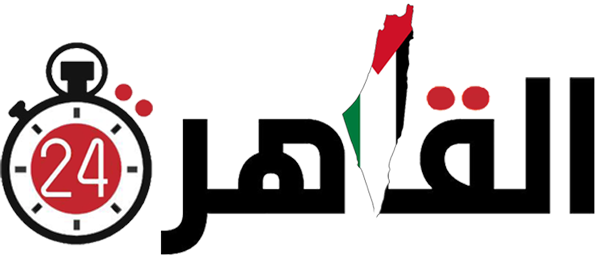الطلاق الشفوي مرة أخرى
منذ عقود ومعدل الطلاق في مصر يشهد ارتفاعا غير مسبوق، ودعا رئيس الجمهورية إلى النظر في الطلاق، بقصد دراسة مدى إمكان عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي الذي يتم غالبا في موقف انفعالي دون شهود ولا توثيق، وفي هذا السياق يأتي هذا المقال.
إن أقوى ما استند إليه الرافضون لتقييد الطلاق بالإشهاد والتوثيق، هو ما تبينه العبارة التالية: "وقوعُ الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".
ونريد في هذا المقال أن نعرض وندرس وجهتي النظر في هذا الموضوع.
يقول الذين يرفضون تقييد الطلاق بالإشهاد والتوثيق: إن الذي سار عليه المسلمون من عهد النبي عليه السلام، أنهم لا يشترطون في الطلاق إشهادا ولا توثيقا. فكيف يدعو اليوم بعضُ المسلمين إلى عدم الاعتداد بالطلاق الذي تم دون إشهاد ولا توثيق؟ فهل كان المسلمون من عهد النبي عليه السلام في غفلة عن ذلك؟ أم كانوا لا يعرفون شريعة الله؟ أم كانوا يتبعون غير سبيل المؤمنين في هذا الشأن الخطير؟
ويقولون: إن الإيمان بثبات الشرع وصلاحيته لكل زمان ومكان، لا يترك لأحد مجالا ليفكر في عدم احتساب الطلاق إذا تم من غير إشهاد ولا توثيق، وعلى الناس أن تتبع شريعة الله لا أن يغيروا فيها، أليس الطلاق مسألة دينية، وعلى المسلم أن يفعله عند الحاجة إليه، على الوجه المعروف في الشرع؟ صحيح أن عددا من الفقهاء قد اشترطوا الإشهاد على الطلاق، ولكنهم قلة في مقابل جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، فجماهير العلماء من عصر الصحابة إلى اليوم، على أنه متى نطق الزوج بكلمة الطلاق غير مكره، واعيا بما نطق قاصدا به الطلاق، فإن زوجته تصبح طالقا في نفس اللحظة في دين الله، ومن يفتي بخلاف ذلك فإنه يوقع الناس في الزنى والعياذ بالله.
ويقولون إذا تبين لك غرابة هذه الدعوى، دعوى عدم احتساب الطلاق الذي تم دون إشهاد، فإن الأغرب منها دعوى عدم احتساب الطلاق إذا تم من غير توثيق عند الموظف المختص بتسجيل الزواج والطلاق، ذلك أن إنشاء دوائر حكومية مختصة بتسجيل وقائع الزواج والطلاق أمر حادث في بلاد المسلمين، لم يعرفه المسلمون إلا في الفترة الأخيرة، وإنما جوزه الفقهاء لما فيه من حفظ الحقوق، التي أصبحت عرضة للضياع في هذا العصر، بسبب فساد الذمم وكثرة الاغتراب وقلة التعارف بين الناس في المدن. فكيف تنعكس الأمور، فيدعو البعض إلى عدم احتساب الطلاق ما لم يكون موثقا؟
ويقولون: إنه لا يمكن تقييد الطلاق بالإشهاد والتوثيق، لأنه لا شأن للشهود ولا شأن للموثق بوقوع الطلاق أصلا، لأن دور الشهود أن يشهدوا بأن فلانا طلق زوجته فلانة، في اليوم الفلاني، ودور الموثق أن يوثق طلاق المطلق وشهادة الشهود، فالشهادة أمر واقع بعد وقوع الطلاق لا محالة، والتوثيق واقع بعد الطلاق والإشهاد لا محالة، فكيف يُتصور عقلا أن يقول قائل، إنه ينبغي أن نشترط الإشهاد والتوثيق في الطلاق وإلا لا يكون طلاقا معتدا به؟ أيظن من يقول هذا أنه حين يَبقى المطلقُ مع مطلقته كزوجين، أنهما صارا زوجين فعلا؟ وأن العلاقة بينهما أصبحت مشروعة وليست زنى؟ إنه تجرؤ على حدود الله، بل هو إفساد للزواج والطلاق معا، لأنه يجعل المطلقة كالمتزوجة.
هذه وجهة نظر من يرفضون اشتراط الإشهاد والتوثيق، لصحة وقوع الطلاق، أنهم يحافظون على نظام الطلاق المعروف من عهد الرسول، ويطلبون ممن يطلق زوجته، أن يبادر إلى الإشهاد والتوثيق، على أن الإشهاد والتوثيق أمران لاحقان للطلاق، لصيانة الحقوق، وليسا شرطين لصحة الطلاق.
والآن علينا أن نعرض وجهة نظر من يطالبون بتقييد الطلاق بالإشهاد والتوثيق، ونعرف إلام استندوا؟ وكيف يوفقون بين ما يدعون إليه وما يسلّمون به من أن المسلمين على مدى تاريخهم من عهد الرسول إلى عقود خلت، لا يشترطون إشهادا ولا توثيقا؟ وهل يرون أن أهل العصور الماضية كانوا على خطأ أو كانوا في ضلال أو جهل بشرع الله؟ وإذا لم يكونوا على شيء من هذا فكيف نفعل ما لم يفعلوه؟ وكيف تنحل عقدة النكاح بين رجل وامرأته أمس، وقد طلقها من غير إشهاد ولا توثيق، ولا تنحل عقدة النكاح بعد صدور قانون يشترط الإشهاد والتوثيق؟ والجميع مسلمون لا يفرق بينهم بلد ولا مذهب؟
يقول أنصار تقييد الطلاق بالإشهاد والتوثيق: إن شريعة الإسلام تتوخى مصالح الناس، وتحرص على كيان الأسرة، وتصف عُقدة الزواج بأنها ميثاق غليظ، وتنظر إلى الطلاق باعتباره (أبغض الحلال)، ولا تتجاهل الطبيعة العاطفية لعلاقة الزواج وما قد يعتري الزوجين من نفور أو خلاف يمكن تجاوزه، ولذلك دعت الزوجين إلى الإصلاح عند الخلاف، وجعلت المجتمع شريكا في إنجاز الصلح، فإذا بنينا على هذه الأمور الأساسية أنه لا يُسمح للزوج أن ينهي علاقة الزواج إلا بعد تعذر الصلح بينه وبين زوجته، وأن عليه أن يبلغ المحكمة برغبته في الطلاق، فتقوم المحكمة بتعيين خبراء للصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح تُعرِّف كل واحد منهما بما له من حقوق وما عليه من واجبات عند وقوع الطلاق، ثم تخبر الزوج أن باستطاعته الآن أن يطلق، وحينذاك يتم الطلاق مشهودا عليه وموثقا، وقد علم كل طرف بما له وما عليه.
وينبغي أن ننتبه هنا إلى أنهم لا يكتفون باشتراط الإشهاد والتوثيق، وإنما يضيفون إلى ذلك إذن المحكمة، فتصبح المحصلة أنه لا طلاق إلا بإشهاد وتوثيق بعد إذن من المحكمة، ولا إذن إلا بعد تعذر الصلح.
ويقولون: إن الطلاق ليس قضية دينية عجائبية، يغالط الله فيها نفسه والعياذ بالله، فهو يقول من جهة إن الزواج ميثاق غليظ، وإن الطلاق أبغض الحلال إليه، وإنه لم يجعل علينا في الدين من حرج، ثم هو في الجهة الأخرى يوقعنا في الحرج بحل عقدة الزواج بمجرد تلفظ الزوج بكلمة الطلاق في موقف ضاغط، بينما فرص الصلح متاحة، والزوج نادم على تورطه فيما قال، والزوجان راغبان في استمرار العشرة، ومصلحة الأولاد والمجتمع في بقاء الزوجين دون طلاق. فإما أن نعدِّل القانون ليسمح ببقاء الزواج في هذه الأحوال، تنزيها للشرع من إيقاع الناس في الحرج والإضرار بالأسر، وإلا فإننا نزعم أن الحرج والضرر من أصل الدين ولا يمكننا رفعه.
ويقولون: حين يتم الطلاق مشهودا عليه وموثقا بعد إذن المحكمة، التي لا تأذن به إلا بعد أن يتعذر الصلح، وبعض البلاد لا تسمح به قبل مضي فترة معينة على الزواج- يقولون: إننا نكون أقرب إلى الشرع ومقاصده ممن يرفضون هذه القيود، بل يكاد نظامنا الحالي للطلاق أن يكون مناقضا للشرع الذي قال صاحبه (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج 78، وهل هناك حرج أكبر من هدم علاقة الزواج بسبب كلمة عابرة، يندم الزوج على قولها، وهل هناك حرج أكبر من تسرع الزوج في الطلاق دون أن يعرف هو وزوجته ما سوف يترتب على الطلاق من حقوق وواجبات نحو الطرف الآخر ونحو الأولاد، فينتقلان من صدمة الطلاق الذي وقع فلتة من غير ترو، إلى شجار على الحقوق والواجبات بعد الطلاق؟
ويقولون: إن الإسلام (دينٌ) من (الأديان) وهو كأي دين، يتضمن عقيدةً هي أفكار أساسية، ويتضمن شعائر هي عبادات تؤدى على صورة معينة، ويتضمن توجيهاتٍ متنوعة تتعلق بأمور مختلفة من أكل وشرب وزواج وطلاق وقتال، وهذه التوجيهات كانت في وقتها إرشادا مناسبا يحتاجه المسلمون، وليس لها قدسيةٌ مثل قدسية العقائد، ولا ثباتٌ كثبات الشعائر، وإنما هي توجيهات ظرفية يجب أن نراعي وِجهتَها، من عدل وإصلاح، دون أن نقف عند هيئتِها ومادتِها. فالطلاق مسألة اجتماعية، ولا يصح أن نعتبره مسألة دينية لمجرد أنه كان مجالا للحديث في عدد من النصوص الدينية، ولا حرج أن نغير في نظامه بما يتناسب مع ظروف عصرنا.
ويقولون لمن لا يسلمون بالفرق بين الشعيرة كالصلاة والأمور الاجتماعية كالزواج والطلاق: افتونا مشكورين، في أسرى الحرب من رجال ونساء، أنتخذ هؤلاء الرجال عبيدا، وتلك النسوة إماءً، ويحل لنا أن نعاشرهن معاشرةَ الزوجات من غير رضاهن، أم لا يحل ذلك؟ فإن قلتم لا يحل ذلك، لأن الأعراف الدولية في معاملة الأسرى قد تغيرت، وأصبحت تمنع من استعبادهم، قلنا لكم: ولماذا لا تتغير الأعراف المحلية المتعلقة بالطلاق، من إيقاع الطلاق بمجرد التلفظ به، إلى عدم إيقاعه إلا مشهودا عليه وموثقا وبإذن من المحكمة بعد استنفاد محاولات الصلح؟ أليست بيوتُنا أولى بالرعاية من الأسرى؟ أم تجدون آية في القرآن لسنا نراها، تقول إن الطلاق من شعائر الله، ولا يجوز تقييد وقوعه بالإشهاد والتوثيق وإذن المحكمة؟
ويقولون: إننا لا نغير شيئا من الشرع، وإنما ننشئ عرفا جديدا، لا يصبح الطلاق فيه مباحا في أي وقت، وإنما يصبح مقيدا بإذن المحكمة، التي تأذن به حين يتعذر الصلح بين الزوجين، ولأن القانون لا يصدر إلا بقبول نواب الشعب الذين يمثلونه، فإننا نكون أمام عرف جديد تنازل فيه الأزواج عن حقهم في الطلاق في أي وقت، ورضوا بأنهم لا يطلقون إلا بعد إذن المحكمة، وكما أن من تنازل عن حقه في الطلاق ومنحه لزوجته، يكون نطقه بالطلاق هدرا لا قيمة له، فكذلك من تنازل عن حقه في إيقاع الطلاق في أي وقت، ورضي بألا يطلق إلا بعد إذن من المحكمة، يكون نطقه بالطلاق قبل الإذن هدرا لا قيمة له.
ويقولون: إن الزواج بالنسبة للطلاق كالأصل من الفرع، لأنه لا طلاق لمن لم يتزوج، وإن القرآن قد لفت أنظارنا إلى أن الزواج (وهو الأصل كما قلنا) مسألة اجتماعية لا دينية، وذلك في قوله بعد سرد أصناف المحرمات من النساء (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) النساء 26، فجعل مرجع تحريم هذه الأصناف من النساء هو استقراء سنن الأمم السابقة، وإذا كان القرآن يلفت أنظارنا عند حديثه عن الزواج إلى الإفادة من العادات الاجتماعية الحسنة عند الأمم السابقة، فإنه من باب أولى يقول لنا إن الزواج والطلاق مسائل اجتماعية لا دينية، وعليكم أن تعدلوا في تنظيمها كلما بعدت الشقة بين أحوال اليوم وأحوال الأمس، ولا حرج عليكم أن تأخذوا فيهما بما سبقت إليه أمم غيركم. وقد تأسينا بغيرنا في الزواج ورفعنا السن الذي يسمح فيه بالزواج.
ويقولون في تبرير الفرق بين رجل عاش من ألف سنة أو مئة سنة، أو منذ أشهر مضت، قال لامرأته أنت طالق، فتم احتساب الطلاق، وآخر قال لها أنت طالق بعد صدور القانون ولم يُحتسب الطلاق- يقولون: إن كل واحد من الزوجين قد مارس حقه في الطلاق وفق العرف المعمول به، فالأول كان العرف يسمح له بأن يطلق متى شاء، والثاني كان العرف الذي أنشأه القانون يسمح بالطلاق وفق ترتيبات معينة، ومنها ألا يطلق إلا بإذن من المحكمة، أمام الشهود والموثق، فالذي تغير هو العرف لا الشرع.
ويقولون: لقد سبقتنا مجتمعاتٌ إسلامية في تنظيم الطلاق تنظيما يتناسب مع ظروف العصر، باعتباره مسألة اجتماعية لا دينية، ويعرضون بعض ما تضمنته مدونة الأسرة المغربية المُحيَّنة في 2016م، فالمادة (83) تنص على أنه (إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم)، والمادة (86) تنص على أنه (إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه داخل الأجل المحدد له، اعتُبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من قبل المحكمة)، والمادة (87) تنص على أنه (بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ المحكمة...).
ووفقا لهذه المواد فإن القضاء المغربي لا يعتد بالطلاق الشفوي بصرف النظر عن لفظه وسياق الحال الذي قيل فيه، ولا يعتد كذلك بالطلاق المكتوب الذي وقع عليه الزوج والشهود، ويعتد فقط بالطلاق الذي أذنت المحكمة بتوثيقه عند كاتبي عدل تابعين لدائرة نفوذها، وهي لا تأذن بهذا إلا بعد تعذر الإصلاح، وتقدير النفقات، وإيداع الزوج للنفقات العاجلة في المحكمة، فإذا ذهب الزوج إلى كاتبي العدل، ومعه إذن القاضي بتوثيق الطلاق، يتم الطلاق ويوثَّق. وتُبين المادة (88) أنه حين يعود الزوج للمحكمة بوثيقة الإشهاد على الطلاق، فإنها تُصدر حكمها بثبوت الطلاق، بعد شرح موجز للمراحل التي مرت بها واقعة الطلاق، وتسرد أسماء الأولاد وأعمارهم، وما تقرر على الزوج من نفقات أداها بالفعل، وأخرى تلزمه في كل شهر، لتكون هذه الوثيقة، مرجعا لأي مراجعة أو نزاع لاحق.
ومجمل القول أنّ الزواج والطلاق من الظواهر الاجتماعية لا الشعائر الدينية، وقد وردت عن الزواج والطلاق نصوص في الكتاب والسنة، وكانت هذه النصوص مادة للدرس عند الفقهاء، وصار ما انتهَوا إليه عن الزواج والطلاق جزءا من الفقه الإسلامي.
وأن الذين يعارضون تقييد الطلاق بالإشهاد والتوثيق، نظروا إلى الطلاق باعتباره أمرا من أمور الشرع، ولم يجدوا الأقدمين ولا من تلاهم إلى عقود خلت قد اشترطوا لاحتساب الطلاق إشهادا ولا توثيقا، فجمعوا هذا إلى هذا وقالوا إن الزوجة تصبح مطلقة حين يقول لها زوجها أنت طالق، مادام واعيا بما يقول ويقصده من غير إكراه، وما دامت المرأة قد صارت طالقا بجملة قالها زوجها، فإن وجود الإشهاد أو غيابه، وحدوث التوثيق أو غيابه، لا يغير من الأمر شيئا، وكلاهما أمران لاحقان على وقوع الطلاق، فلا يمكن أن يكون أحدهما شرطا لوقوع الطلاق.
وقال الآخرون إن الله غني عن العالمين، ولم يقصد بأمر ولا نهي إلا مصالح العباد، وإنه حيثما وُجدت المصلحة فثَمّ شرع الله، وإن الشريعة تحرص على كيان الأسرة، وتصف عُقدة الزواج بأنها ميثاق غليظ، وتنظر إلى الطلاق باعتباره (أبغض الحلال)، ولا تتجاهل الطبيعة العاطفية لعلاقة الزواج، وما قد يعتري الزوجين من نفور أو خلاف عارض، وأنها دعت الزوجين إلى الإصلاح تجنبا للطلاق، وجعلت المجتمع شريكا في إنجاز الصلح، وبناء عليه، فإنه من الخير للمجتمع أن يُلزَم الأزواج بهذه الخطوات، ولا يسمح لأحد أن يتجاوزها، وليس في الأمر تغيير لأحكام الشرع، وإنما فيه إحداث عرف جديد، ينشئه القانون.
والذي أتصور أن الأمور ستصير إليه في بلادنا وفي عامة البلاد الإسلامية هو تقييد الطلاق بالإشهاد والتوثيق وإذن المحكمة، وفق ترتيبات تختلف شيئا قليلا من بلد إلى بلد. وإلى اليوم تأخذ بهذه الترتيبات على نحو إجمالي أربعُ دول إسلامية، هي ماليزيا وإندونيسيا وتونس والمغرب، فلماذا تتأخر بلادنا عن هذا الإصلاح؟ أليس الطلاق وفق ترتيبات ينظمها القانون خيرا للأزواج والزوجات والأولاد والمجتمع والمحاكم من طلاق عشوائي، نتج عن كلمةٍ تسرع بها الزوج، أو قالها دون بصيرة بما يترتب عليها، أو قالها في ظرف ضاغط ثم ندم عليها؟
وهل ينجرح الشرع الحنيف بإلزام الناس بإجراءات قد ندبهم إليها، أو ينجرح بعدول بعض الأزواج عن الطلاق وهو أبغض الحلال إلى الله؟ وهل ستبقى كلمة الطلاق على ألسنة الأزواج عند الشجار بعد صدور القانون؟ وهل سوف تبقى مكاتب الإفتاء عامرة بالأزواج الذين يسألون عن احتساب أو عدم احتساب الطلاق الذي لفظه كذا في الظرف الفلاني؟ وهل سوف تبقى المحاكم عامرة بقضايا النفقة والحضانة والرؤية بعد الطلاق؟ إن شيئا من هذا لن يكون، وكفى بذلك مكسبا للأفراد والمجتمع والمحاكم.