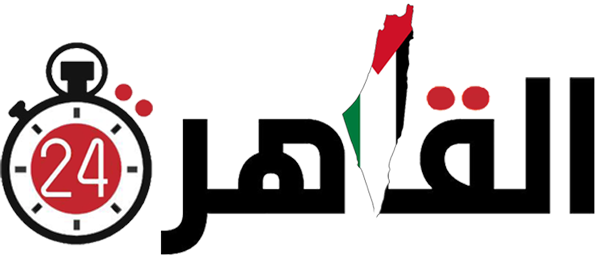المماليك الجدد في مصر
هذه رواية تختلط فيها التراجيديا بالكوميديا، لتصبح أحيانًا كوميديا سوداء تُثير فينا الضحك الممزوج بالبكاء على حال مصر، وتحولات وتشوهات مجتمعها وناسها في زمن الانفتاح الاستهلاكي، أو زمن "الانفتاح السداح مداح" كما أطلق عليه الراحل الأستاذ أحمد بهاء الدين في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وهي التحولات التي أدت إلى تكوين طبقة من "القطط السمان" أو "المماليك الجدد" الذين تسللوا إلى موقع النفوذ والسلطة، وسيطروا على مقاليد الأمور في مصر، وتاجروا في كل شيء من البيض والفراخ حتى الأثار والمقاولات والإعلام وإنتاج الأفلام السينمائية.
بطل هذه الرواية هو الأكاديمي "الدكتور نظمي" ابن الطبقة الوسطى المصرية، الأستاذ في الطب النفسي، الذي تخرج بامتياز في كلية الطب وعمل بجد حتى أصبح أشهر الأطباء النفسيين في مصر، وصارت عيادته أهم العيادات النفسية في البلد، والذي تزوج من امرأة جميلة هي "محاسن هانم"، التي أنجبت له خمس بنات في قمة الجمال.
بدأت مأساة الدكتور نظمي عندما طلبت زوجته منه الطلاق بعد ثلاثين عامًا من الزواج، لكي تتزوج تاجر انفتاحي من المماليك الجدد اسمه "الدكش" يمتلك بوتيكات في شارع الشواربي وبورسعيد، ويمتلك ما لا يمكن حصره من شقق وعمارات في القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المدن.
وقد وقعت "محاسن هانم" في قبضة "الدكش" بعد أن ذهبت هي وبناتها إلى شارع الشورابي لشراء ما يحتجن إليه من ملابس واكسسورات. وهناك رآها وقرر أن يغويها ويحصل عليها، كما تعود أن يحصل بأمواله على كل شيء.
المفارقة المحزنة، أن "محاسن هانم" استجابت لتلك الغواية في لحظة هشاشة داخلية ووجودية دون تردد، وقالت في نفسها: "كفاية ثلاثين سنة زواج من هذا الرجل، ومرحبًا بسنوات زواج جديدة من ذلك الرجل... فماذا يمكن للدكتور نظمي أن يقدم لها والدكش يأتي لها بلبن العصفور".
وقد تم الطلاق بسرعة، لتتزوج "محاسن هانم" من "الدكش"، وتأخذ بناتها معها إلى حياتها الجديدة، ليتحول "الدكتور نظمي" بسبب تلك الصدمة والخسارة إلى مريض نفسي يتم حجزه بالمستشفى، ثم يعتكف بالأيام في بيته، ويفقد اهتمامه بالعيادة والمرضى، ويبدأ في تعاطي كل الممنوعات التي كان يُحرمها على مرضاه.
وكل ذلك بالطبع للهروب من مرارة الهزيمة النفسية والاجتماعية التي تجرعها أمام "الدكش"، الذي سلبه الزوجة والأولاد والسلام النفسي، حتى أصبح يا مولاي كما خلقتني! بلا أسره ولا بيت ولا ولا عمل.
بل أن موت "الدكش" بعد أن أصيب بسرطان في المسالك البولية، لم ينجح في مسح أثار تلك الهزيمة القاسية التي تلاقها الدكتور نظمي، وفي تلافي أثار الخراب الذي صنعه هو وأمثاله في الكثير من البيوت والنفوس.
وقد دفع هذا الخراب الدكتور نظمي للقول في نهاية الرواية: "سيان أن تبقى أو تموت يا دكش، بقايا قلاعك في كل مكان... مات العشرات من المماليك، ولكنهم كانوا قد خربوا آلاف الديار، ومحاسن أصبحت منهم، وانتهى الأمر. انسكب اللبن وأنت يا محاسن تركتيني، واخترت ذلك الإنسان، وستظلين نفس الإنسانة التي هجرتني حتى لو مات الدكش".
وبهذا تكتمل مأساة "الدكتور نظمي" ومأساة زوجته وبناته، ومأساة المجتمع المصري في زمن الانفتاح الاستهلاكي الذي شهدته مصر في سبعينات القرن العشرين، ولا نزال لليوم نُعاني من أثاره السلبية على الشخصية والثقافة المصرية.
وهي المأساة التي رسمها لنا ببراعة كبيرة الأديب الراحل "عبدالفتاح رزق" في روايته "يا مولاي كما خلقتني" الصادرة ضمن سلسلة "روايات الهلال" في أكتوبر 1989.
وأظن أننا نحتاج الآن في ظل حرب الدولة الدائرة على الفساد، وعلى كل من نهب المال العام، وأضاع حق الدولة، للعودة لقراءة ودراسة تلك الرواية المهمة؛ من أجل فهم سياق وبداية التحولات التي أدت لنشأة طبقة المماليك الجدد في مصر، وأوصلتنا لما نحن فيه من تشوه فكري وقيمي وأخلاقي، وجعلت المواطن المصري الأصيل يا مولاي كما خلقتني.
وخاصة أن "الدكش" وأمثاله من المماليك الجدد لا يزلون فاعلين ومؤثرين في مجتمعنا لليوم، ويحاولون المحافظة على مكتسباتهم، ومقاومة الإصلاح والتغيير، وصب فكرهم الرفيع في عقول المصريين.