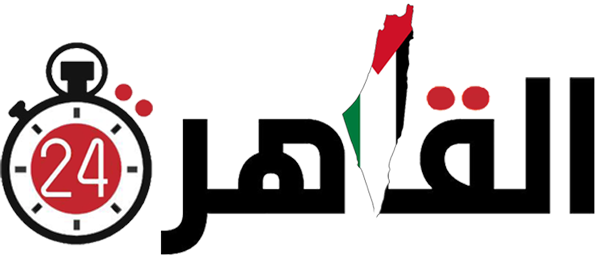حسرة.. قصة قصيرة لمرفت البربري

إبلاغ المريض بمرضه مهمة قاسية، وأنا مهنتي الاتصال بمرضى كورونا لإبلاغهم بنتيجة فحصهم المخبري، وبأن يستعدوا لاستقبال سيارات الإسعاف التي ستنقلهم للحجر الصحي، هاتفت اليوم مريضة على رقم تركته في بياناتها، وعند اتصالي اكتشفت أنه رقم جارتها لأنها لا تملك هاتفا، طلبت أن تصلني بالمريضة ذاكرا اسمها فقط دون أن أخبر صاحبة الهاتف بالغرض من اتصالي، أخبرتني أنها ستعاود الاتصال بعد أن تخبرها، انتظرت دقائق حتى جاءني اتصالها، أبلغتها أن تستعد للحجر، فجاءني ردها غريبا..
- حاضر يا حسين يا أخي سوف أحضر إلى القرية لرعاية الحاجة شفاها الله.
حاولت أن أعيد الغرض من اتصالي ولكنها همست بصوت منخفض
- أرجوك سوف أتصل بك من رقم آخر.
بعد دقائق اتصلت أم محمد لتستعطفني أن يكون مكان استقلالها عربة الإسعاف هو مكان المدرسة التي تعمل بها، وألا تأتي السيارة إلى منزلها، كي لا يعرف الجيران، ويتنمروا على أولادها أو ينبذونهم خوفا من العدوى، سألتها عن مدرستها وتركتها تسترسل في الكلام.-
- أغلقت مدرستي التي أعمل بها عاملة نظافة، أهتم بالأطفال الذين في فصول الروضة، أرعاهم كأبنائي، أنظف أجسادهم بعد دخولهم دورة المياه كأمهاتهم، أرتب ملابسهم وأغسل وجوههم ليخرجوا وهيئتهم أفضل مما دخلوا، مازن طفل جميل يسعدني وجوده ككل الأطفال وأنا اهتم به مثلهم ويزيد اهتمامي له بسبب مراعاة والده لي فهو بين الحين والآخر يمنحني المال، ويقدر عملي واهتمامي بالأطفال، كان دائما عندما أرفض تناول عطيته يقول لي، أنت يا أم محمد أهم من مدير المدرسة، وكان يجبر خاطري بكلماته كي لا أستحيي من أخذ المال، كان رجلًا ثريًا يعمل بالخارج، ويسافر كثيرا، وللأسف أعطاني مع المال الفيروس اللعين، وكان سبب إغلاق المدرسة لمخالطة ابنه له، والله أنا لا أحقد عليه بل أدعو له أن يشفى ويعود لأولاده سالما، ولكن أبناء حارتي ورثوا مع الفقر قسوة، لا أريدهم أن يعيروا أطفالي بمرضي، أو يخافوا منهم، طلبت من جارتي رعايتهم حتى أعود، وأخشى أن تخاف منهم فتتركهم يضيعون، فقد مات أبوهم وليس لهم غيري، أرجوك سأنتظركم عند باب المدرسة فأنا أخبرت الجميع أن أمي مريضة وسأسافر لرعايتها.
سمعت حديثها ولم أرد دموعي أخرست لساني، وافقتها وأخذت عنوان المدرسة وهناك ركبت سيارة الإسعاف لتذهب في رحلة ربما لا تعود منها.
أغلقت هاتفي النقال وتحركت فى أرجاء مستشفى العزل التي أعمل بها سمعت مريضا يتحدث مع طبيبه.
- فر مني أبي وأخي، تباعدوا عني أمتارا، كي لا يصابوا بالعدوى، كم هو مؤلم شعور المنبوذ من أحبابه، وحدها أمي اقتربت، لامس حنانها جبيني الملتهب، ألصقت كفها بجبهتي، في محاولة أن تمتص حرارتي بيدها، لم تجدِ محاولاتها لإنقاص حرارتي، بالماء البارد والمشروبات والأدوية، تمنيت لحظتها أن أكون مصابا بأقسى الأمراض، تذكرت صديقي الذي أصابه السرطان، كيف كان حضن أهله شافيا قبل العلاج، أما أنا فنظرات الرعب التي رأيتها في عيون أقرب الناس قتلتني بسكين بارد، لم أتحمل،، وعندما جئت للعزل تلقفني الأطباء بكل أنواع الحذر، وكأنني كائن قذر يخشون لمسه، ولكنني أعذرهم، وبعد قيامهم بالإجراءات والتحاليل، ظهرت سلبية المرض، ولكنني عندما سأعود إلى أهلي سيحول موج نظراتهم السابقة بيننا، لن أرَ إلا جبل التنائي الذي استعصموا به من لجة العدوى بمرضي، إلا أمي سفينة نجاتي التي سالزم قدميها اتشبث بمجاديف حبها، وأرسو على مرفأ صدرها، سأظل أقبلها لأجد راحتي في لمستها الحانية، لمستها التي برأت بها غُلة دائي، وانطفأت بها نيران حقدي على من نبذوني.
رد الطبيب:
- ربما حالك كان أهون فانت لازلت شابًا وبصحة ومناعة جيدة وسوف يمر المرض عليك أهون من كبار السن، منذ أيام مريض من كبار السن أخذت دموعه تستعطفني بعدما تأكد أنه يحتضر، طلب أن يودع أبناءه قبل أن يموت، كان تحت جهاز التنفس الاصطناعي وحالته لا تستجيب للعلاج، أتى إلى الحجر الصحي بعد عودته مباشرة من غربته التي أكلت شبابه ونخرت مصاريف المدارس والكليات الخاصة عظام كاهله، عاش في غربته لا يرى أبناءه إلا لمما، قال لي أشتقت دفء أنفاسهم، كانت آخر مرة رأيتهم فيها منذ ثلاثة أعوام، كنت أوفر ثمن تذكرة إجازتي السنوية لأرسلها لهم، اعتبرت شاشة (السكايب والماسنجر)، مهدئ من غلة شوقي لهم، فأكلمهم يوميا وكأني معهم، أو قل كنت أوهِم نفسي بذلك، تأثرت بكلامه وأحسست بشوقه لفلذات كبده، رتبت كل شئ حتى يدخل الأبناء لرؤيته في أمان، ويخرجوا بأمان، أجريت مكالمة هاتفية أخبرهم برغبة والدهم، كان ردهم، أن الوداع يؤلمهم ولا يودون رؤيته بهذا الحال، في موعد مروري عليه، كانت نظراته تخترق قلبي، لم أستطع الكلام ولكنه أوصاني ألا أخبرهم عن مكان مقبرته.
نزلت سلم المستشفى رن هاتفى كان المتصل مريضا كنت قد أخبرته موعد ذهاب الإسعاف إليه لينقلوه إلى المستشفى، عندما ضغطت زر الإجابة سمعت صوت محدثى على بعد درجات من السلم، أغلقت الهاتف وقلت له:
أنا من تتصل به، هل أستطيع مساعدتك.
عندما هاتفتني أمس، عتمت الدنيا والشمس تزين صدر السماء ببريقها الذهبي، خرست كل الأصوات من حولي، أبواق الباعة.. شجارات الناس.. منادي سيارات الأجرة الواقف على باب سيارته يجمع القروش الملقاة على الأسفلت بجاروف ندائه، معلنا عن الطريق الذي تطعنه عجلات سيارته ذهابا وإيابا، شكاوى النساء المتبادلة التي يسمعها البعيد قبل القريب، فقط صوت واحد كان يملأ مسامعي وخلجاتي، احتوى كل ذراتي، هو صوتك، استفاقت له حتى شعيرات جسدي التي لا ألقي لوجودها بالا، فأحسست بها تنتفض لما سمعته وكنت أظن أن الحديث فقط يخرج من الهاتف إلى أذني فإذا بها تحتوي كل جسدي، والصوت يخترق مسامي، أخبرتني بأن نتيجة التحليل إيجابية، وأنني لا بد من حجري في المشفى، أنا لا أخاف الموت، وأرضى بآلام المرض وأحتملها.. فهي مطهرة من ذنوبي وقربى من ربي، كل ما آلمني..مصير صغاري، الذين أعود لهم قرب الصباح بقوت يوم بيوم، كان أصدقائي وجيراني يحسدونني على عملي كسائق ويزداد حسدهم عندما يعرفون أنني أُقِل سائحا، ويتوقعون أنه يغدق علي العطاء، أصابني ذاك السائح بالعدوى وكان كريما، لم أستطع حتى وداع صغاري خوفا من أن أعديهم، توجهت أسلم نفسي للأسعاف ليأخذوني للحجر الصحي، إلتقيت على بابها بجاري الطبيب صاحب المستشفى الخاص بحينا والذي كان في صغرنا صديقي، حاولت أن أكلمه لأوصيه بأولادي، فاستعصم بسيارته، غلّق أبوابها والنوافذ، وانطلق.
مد يديه بورقة بها عنوان صغاره، وقال لى:
- صوتك أخبرني بإنسانيتك، وأنا أتعشم ألا تخذلني كما خذلني صديق الصغر، فقط أريد الاطمئنان على صغارى، وإن مت.. أخبروهم ألا يحزنوا.
طمأنته وفعلت له ما أراد وكنت سعيد بهذه المهمة التى أراد الله أن يجعلني بها سببًا لراحة ذلك الرجل من خوفه على أطفاله، وزادت سعادتى عندما هاتفني بعد تمام شفائه.
لم يسلم بيتي من الوباء، فأصيب أبي وكانت البداية مغص بسيط تلاه قيء، ثم بدأت أعراض أخرى في الظهور، وكأنهن يقفن على باب رئته العطباء من أثر التدخين، التهمنها في وقت قصير، لم تجدِ كل بروتوكولات العلاج والعزل المنزلي، كانت حرارته تزيد وتزيد معها حرائق الخوف عليه في صدري، كل مستشفيات العزل رفضت استقباله، بسيارتي أخذت أدور به على المستشفيات الخاصة، لكن ميزانيتي هي التي رفضت هذه المرة، لأنني ببساطة كل ممتلكاتي التي بعتها لم تقوَ على دفع فاتورة يوم واحد للعزل في إحداها، تواصل معي صديق ودلني على مشفى يمكنه استقبال والدي، طرت بسيارتي إليها يجلس بجواري جسد هزيل هو ما تبقى من والدي، على بابها رفضت رئته استقبال الهواء، رحت أٰقبِله قبلة الحياة، ليتني معها أمنحه حياتي، أو تحمل رئتي عنه الفيروس اللعين، أبى المرض إلا أن يوقع على شهادة وفاته في خانة الفاعل(سبب الوفاة)، فاضت روحه بين يدي رئتيَّ التي امتلأت من بقاياه، على باب المشفى رأيت عجوزا محمولة لمثواها، ماتت بعد التعافي من الوباء، عندما نبذها الأبناء ورفضوا تسلمها،،
لعدم وجود مساحة لها في حياتهم..
بعد أن دفنت والدي عدت إلى عملي والاتصال بالمرضى، كان الاتصال اليوم من مريضة وكان ابنها قد قام بعزلها منزليا وبعد محاولات للعلاج المنزلي، وسهر نحو اثنى عشر يوما تحت قدميها العجفاوين، ساءت حالة أمه ذات النيف وثمانين عاما، كان وليدها الصغير، كل من بقيَّ بجانبها بعد أن تزوج الأبناء والبنات وبعد أن مات والده منذ عامين، كان لها كل شئ، وكانت عالمه، يرعاها وترعاه حتى أصابها الوباء، ترك عمله والدنيا وسكن موطئ قدميها، ولكنه عجز أن يعينها على الانتصار على مرضها، أصابها الوباء بأعراض لا يمكن مجابهتها بالأدوية العادية، استدعى الإسعاف فأخذوها للعزل، بعد أن حملوها ممددة لا تستطيع حراكا،بينما أنفاسها تتلاحق، وصدرها محاولا ضم أنفاسها يصعد يلتقط نفسا ولا يلبث ينزل ليزفره بسرعة ليستطيع الإمساك بشهقة أخرى، صعدت وحدها سيارة الإسعاف ومنعوه من أن يرافقها، أسرع بجلب سيارة أجرة وحاول وسائقها متابعة عجلات الإسعاف التي تطعن الأسفلت بخطواتها، وتملأ الجو بنفيرها صراخا، وقف على باب المشفى، لا تطاوعه قدماه ليعود إلى البيت بدونها، حاولت أن أثنيه عن مكوثه على باب المشفى، ولكم حاول أن يعرف مكان حجرتها فلم يسقِ عطش لهفته أحدًا، حتى حنت لدموعه عاملة النظافة التي رأته لا يبرح باب المشفي، فقالت له:
- أنا أعرف مكان حجرة العناية الفائقة.
تهلل وجهه الشاحب ومسح دموعه، وقال لها:
- سأمنحك ما تريدين إن أنت أخبرتني أي تلك النوافذ هو نافذة حجرتها. قالت:
- سأصعد وأطل عليك منه وحينها ستعرفه، فأنا يا بني لا أعرفه من هنا، ولا أريد منك شيئًا إلا أن تدعُ لي أن يحبني إبني كحبك لأمك.
دعا لها وقال:
- والله سأدعو لك كل صلاة أن يحبك ويبرُّك.. ولكن كوني له كأمي، ليكن لك مثلما أنا لها..فأمي من علمتني البر ومراقبة الله في كل ما أعمله، هي الحب والحنان والقدوة.
أطلت من نافذة الحجرة فعلم أن ههنا ترقد روحه، تسلق الجدران حتى تمكن من الجلوس على مصطبة النافذة، ورأي أمه أخيرا بعد مرور يوم كامل لم تبصر عيناه فيه إلا دموعه، جلس هناك يراقب الأجهزة التي أوصلوها بجسدها لتمنحها ما يساعد جسدها على مقاومة الوباء، كان لا يفارق النافذة إلا في مواقيت الصلاة يصلي فروضه ويمنح جسده بعض دقائق من الراحة ليعود إلى نافذتها مستندا على كتف ألواحها التي ترفقت به ومنحته من خلفها نظرات أمه الراقدة، كان الأطباء والعاملين بالمشفى يرقون لحاله، فما منعه أحد من تلك الرفقة الافتراضية عبر النافذة، وكانوا وأنا منهم من نمنحه كسرة خبز يسد بها رمقه، وكان لا يتناولها إلا وهو عنها راغب، وكان يقول:
- ما لي في الطعام حاجة وأمي لا تقاسمني مذاقه.
إلا أنه ما كان يريد أن يرفض مودة من يقدم له العون، فكان يتقبلها شاكرا لهم كل صنيعهم معه، مر أسبوع على مرافقتها عبر النافذة، يمدها بدفقات من أنفاسه مع الهواء ربما تمنحها حياة، ويلقِمها دعواته، ومن عينيه يرسل حنانًا يغطي جسدها الرقيق، ولكنه لفرط رقته لم يتحمل المرض، ففارق الحياة جسد على كل البلاء كان صابرا، أرادت أمه أن تريح جسده من تعلقه بالنافذة، ولكنها لا تعلم أن روحه مازالت هناك تزفر وتشهق وجعًا.
أضحت الأيام قاتمات هلت دواجيها بعدما استشرف المرض والهلاك أبواب ضواحيها، تجمع في مشارقها مغاربها ولياليها الهم الخوف والرعب، المرض لبس ثياب التنكر المرعبة، لكنني شاهدت بعد موت أبي، أجداث تتحرك تروح وتغدو، يملؤون أكفانهم بضائع، من كل شئ، مأكولات مطهرات منظفات، تساءلت، هل سيحتاجون كل هذا في القبور؟
ما أعلمه أن تراب القبر طهور، وأن الجثث طعام الدود، أعرف أن كفن الصالحين.. صلاحية بياضه حتى قيام الساعة، أم أن هذه الأطعمة سيقدمونها للديدان قربانا فلا يتناولون جيفتهم فتظل سليمة؟
ربما ليعودوا مرة أخرى فيشقون الأرض، لحياة جديدة؟
لم يلبثوا إلا عشية ما بلغوا ضحاها، حتى سمعت أن جنازتهم قامت، ولحدوا في قبور بلا مبردات تحفظ الطعام، وعلمت ان الدود من موظفي هذه اللحود لا يُرشى بالطعام وسيأكل جثثهم لا محالة، أما ما كانوا يكنزون، فقد ورثه فقراء الحي الذين لا يملكون مالا.. أجسادهم التي خشيها الموت، كان المرض قتيلًا في أحشائها فهي خزائن للمناعة التي صارعت المرض، أما ما تبقى من فضلات ما كانوا يكنزون، خرج من أمعاء الفقراء وتسرب إلى الأجداث.