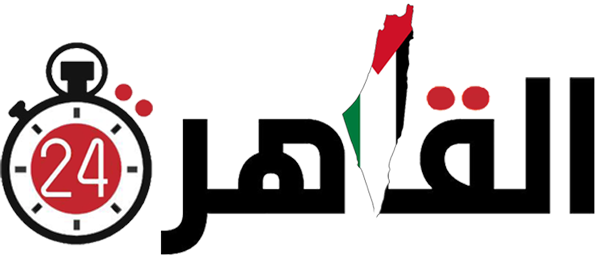شاكر المغربي يكتب: نظرية المؤامرة في "فوق الجاذبية" للروائي أحمد الشدوي

حين يفكّر الكاتب -أيّ كاتب- في كتابة رواية، عليه أوّلًا أن يطرح على نفسه سؤالين -غير ماذا أحكي- وهما لماذا أحكي وكيف؟ فالحكاية ربما أو في أغلب الأحيان لا تُهم القارئ -أقصد نفسي- بقدر ما يُهمّه ماذا يريد الكاتب أن يقول؟ ما هو المغزى من الحكاية؟ أو ما الذي استطاع أن يراه ولم أره؟ ثم كيف يصوغ ذلك من خلال حكايته؟ ليجذب القارئ إلى عالمه ورؤيته دون مللٍ أو نفور، مانحًا إياه بعضًا من المتعة.
وأوّل ما يجذب القارئ -غير اسم الكاتب وشهرته- هو عنوان الرواية، وصورة الغلاف، فالرواية من وجهة نظري مثل بيتٍ عرضه صاحبه على الناس، ليكون مزارًا لهم، ولجذب الناس، زيّن البيت من الخارج، ووضع مع الزينة مفتاح الباب، فصورة الغلاف هي الزينة، ويكمن المفتاح في العنوان، فلا يصح -مثلًا- أن أحكي عن رجل فرنسي وأضع على الغلاف صورة لرجل من أصول إفريقية أو شرق أسيوية، إلا إذا تضمّنت الحكاية أنّ له أصول من هنا أو هناك، وينطبق ذلك على اسم الرواية.
ومن هنا أدخل في الحديث عن البيت الذي أقف أمامه الآن، أتأمّل صورة على جداره لمجموعة من السحب، تشير بلا شكٍ إلى مفتاحه الأوّل "فوق الجاذبية" أمّا العين فقد أحالتني مباشرة إلى التراث الإسلامي حيث المسيخ الدجال، وربما تكون مجرد عين، صعدت إلى ما فوق الجاذبية لترى العالم من هناك، غير أنّني ومع التدقيق في العين رأيت موانئ ساعة، أرسلتني في اتجاه آخر ليس ببعيد عن المسيخ الدجال، لكنّه أكثر حضورًا وقوة، ويتمثّل في رمز الماسونية، حيث العين الواحدة أعلى هرم الدولار الأمريكي، والتي ترى وربما تتحكم في كل شيء.
ومع خطواتنا الأولى داخل البيت "الرواية" نلتقي بيافطة معنونة بإهداء، وهو إهداء أراه مراوغًا، فهو يُوحي لزائر البيت أو القارئ بأنّ المُهدى إليهم شخصيات حقيقية من الواقع، غير أنّهم ليسوا -كما أرى- سوى أبطال الرواية المكتوبة، أو القابضين على مفاتيح غرف البيت برمزية أسمائهم، كم أنّ كل واحد منهم يحمل معه قطعة من الأحجية التي نثرها الراوي داخل الحكاية، وتظهر أوّل قطعة من الأحجية عند دخول الغرفة الأولى، من الغرف الاثنين والعشرين، أو الفصل الأوّل من الرواية، حيث يبدأ الراوي حكايته بفعل مبني للمجهول "أُدخِل خالد للكبسولة" وكأنّ خالد لم يدخل برغبته وهناك ما دفعه لذلك.
ومع إدخال خالد لتلك الكبسولة، توشوش له رؤيا باسم رمضان، الذي آثر الراوي -عن قصدٍ كما أرى- أن يبثّه للقارئ في حالة من التشظي، بين صورة مهزوزة، وخارطة تختفي، وفراغ لا متناهي، وحين وصل لحرف الضاد، وصفه بالوضوح كإشارة أو كرمزية للغة العربية والعروبة، واسم رمضان في مجمله ما هو إلا رمزية للإسلام، صاحب الصورة المغلوطة والمشوّهة في عقل الآخر "إذا رأيت خالد قمت في داخلي بتصديق جدي الذي يقول كل العرب قتلة ولا يهمهم الموت وكان يفترض إبادتهم" ص 210.
ومع نهاية حرف الضاد ومع ظهور حرف الألف الذي وصفه خالد بالهراوة، غير أن تلك الهراوة كما يراها الآخر "الغرب" حدثته عن نفسها "تقول كل ما قيل عني ليس صحيحًا... بل من اختراعهم وأنا سكت عنهم فأنا كنت أوّل حروف القراءة" ص 8 ثم يُؤكد الراوي ذات الفكرة للصورة المغلوطة فيقول في الفصل الثاني "هذه واحدة من أهم قوانين رمضان، ليس من قوانينه التي وضعها، بل من قوانينه التي أجازوها" مؤكدًا في ذلك الفصل عل أنّ أغلب ما قيل عن رمضان ليس سوى أساطير من صُنع الآخر، غير أنّ رمضان خلال محاولاته لتحسين صورته أمام جيل جديد كان يروي أرضه بموتور إنجليزي، متمسكًا بهراوته القديمة، والتي أرى -من وجهة نظري- أنّها -أعني الهراوة- البطل الحقيقي للرواية، فهي السلاح الذي دافع به رمضان عن أرضه، "ولولا تلك الهراوة لما بقيت أرضنا" ص 104.
وهي نفس السلاح الذي استوحاه منه حفيده خالد حين اجتمع عليه -وهو مفتول العضلات- أربعة من المتشردين، فأوسعهم ضربًا ربما بذراعه وربما بصور المراجع "كان يمشي في الشارع من دون المراجع التي حصل على صور منها قبل ساعات" ص 26 فلا مجال في عصر العلم للخرافات والأساطير فبجوار هراوة خالد التي تكمن في قوته ووقوفه على أرض ثابتة متعلقًا بسماء حبه لرؤيا، هناك هراوة أخرى، هراوة جديدة سعت رؤيا لامتلاكها، أثناء رحلتها لمعرفة الله "حينها بدأت فكرة أنّ كل شيء وفق نظام الكون لا وفق الموروثات الدينية والعاطفية التي يبثها أناس لم يعرفوا عن الله إلا فكرة العذاب والنعيم" ص 60.
وأكد الراوي على ذلك "كان هذا القرار هو الهراوة التي استخدمتها رؤيا لإعادة صياغة الحقوق والواجبات" فالهراوة الجديدة هي العلم "قرأت العلم بمنظور جديد، فتعرفت على الله كأعظم ما يكون، وأعادت تشكيل أمثلة الأنبياء، لأنّها تدرك أنّ الله أتقن صنع كل شيء، وكل شيء يسبح إليه" ص 242.
وبالعلم تستطيع أن تمحو تلك الصورة المشوهة عن العرب والإسلام بأنّهم مجرد فئران تجارب "قال توماس: أنا أحب العرب وأشفق عليهم، لا زالوا أدوات تجارب للعالم كله شرقه وغربه" ص 71 وكما وصفهم الراوي أي العرب "التقيا بالأيدي والعيون، فضجت الأرض بالتصفيق. الصينيون يهتفون، والكنديون يغنون، والعرب ينظرون" ص 243.
وأكد على ذات الفكرة عن العرب حين قال "فرقص معهم العالم، الصينيون يتعانقون، في جنوب إفريقيا يرتفع صوت الطبول، والعرب يشتمون حظوظهم التي لم تهيئ لهم حفلا كهذا" ص 244، ومع هذه الصورة المشوهة للعرب والتي في أغلبها حقيقة كانت رؤيا رغم طموحها قد غفلت عن حقيقة ما يدور حولها "رؤيا القادمة بسرعة لعالم ناسا والفضاء لم تدرس التاريخ جيدًا، رؤيا التي عيونها على السماء لم تدرك أنّ في الأرض كثيرًا من الحفر" فكان لا بد من وجود هراوة أخرى من الوعي بالمؤامرة، فكان خالد الذي درس تاريخ الفن، وخاصة تاريخ دافنشي، الذي تحمل رسوماته واختراعاته رموزا وشفرات عجز الكثير من الناس عن فهمها، والتي ربما تكون مجرد أساطير حِيكت حوله مثلما حِيكت حول رمضان "أعرف أن دافنشي رسم نفسه لوحة من الألغاز متعمدًا وأوحى إلى تلاميذه بذلك" ص 121.
ورغم أن الجملة صيغت على لسان رؤيا، إلا أنها غفلت عن أن الفكرة أكبر من ذلك، وهي السعي لهدم فكرة الله والدين من خلال مؤامرة ناسا للتحكم في عقول البشر، فيسعى الراوي من خلال خالد لفتح عيون الناس وكشف تلك المؤامرة عسى أن تكون لدينا رؤيا "حلم خالد" نسعى لتحقيقه دون أن نتخلى عن رمضان "عروبتنا وإسلامنا" حيث يختم الراوي حكايته بخلود الرؤيا ورؤيا الخلود على لسان رمضان "وحينما سأله أحدهم لم ترقص يا رعاك الله، قال: حين سمعت جيمس يقول تلك العبارة لخالد أدركت أن خالدًا نجا بحبيبته، ستشاهدون رؤيا فتاة يانعة. تحمل خالدً وخالدٌ يحملها".
وفي النهاية أقول، إنّ ذلك المنحى الذي آثرت أن أنتحيه أثناء الكتابة، ليس المنحى الوحيد، فداخل الرواية الكثير من الإضاءات لمناحٍ عدة، وأختم بمقولة فريدريك نيتشه التي بدأ بها الراوي فصله الأخير. "كل الأشياء خاضعة للتأويل، وأيًا كان التأويل فهو عمل القوة لا الحقيقة".