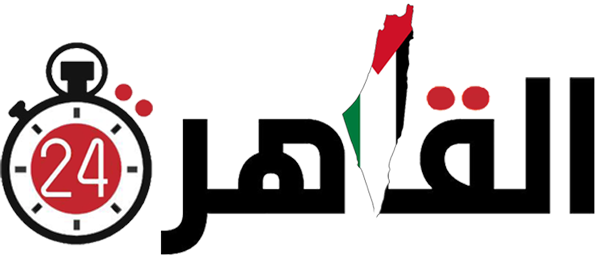رجب أبو سرية: أدب المقاومة انكمش.. والفلسطيني يدافع عن تراثه بأظافره وأسنانه (حوار)

الروائي الفلسطيني رجب أبو سرية، أحد الأصوات الأدبية المميزة خاصة فيما يخص المقاومة والنفي، وله العديد من المؤلفات منها دائرة الموت الحاصلة على جائزة سعاد الصباح عام1991، «عطش البحر 1994، نبوءة العرافة 2003، عرين الجسد 2020»، ومن المجموعات القصصية «ليس غير الظل 1996، تهاويم الأرق، 1998، نثار الروح والجسد 2005»، وغيرها العديد من المؤلفات المسرحية والنقدية.
«القاهرة 24» التقى الروائي الشهير وكان لنا معه هذا الحوار..
جئت إلى مصر في السبعينيات.. كيف أثر الانتقال إلى هنا في حياتك وكتاباتك؟
كنت شابا قرويا، قليل الخبرة والتجربة والثقافة، وكنت أحلم بمصر عبد الناصر وعبد الحليم حافظ، بلاد الفن والثقافة، لذا فقد تعرّفت سريعًا على مثقفي السبعينيات من الشعراء والقاصّين، لكني لم أغطس في الوسط تمامًا، حيث كنت أحس أني بحاجة إلى أن استكشف وأتعرف على الحياة من الشارع أكثر، لا من بين حروف وفزلكلات المثقفين.
وعلى ذلك أظن بأني تعلمت من الناس كنه وجوهر الحياة، خاصة في المدينة بتفاصيلها وتحضرها، وأنا قبل مجيئي لمصر كنت خجولًا فتعلمت الجرأة والشجاعة في كل شيء، في نفس الوقت لم أعرف في مصر إلا الوجه الجاد، الثقافي الملتزم، رغم أن الفترة كانت فترة انفتاح، وحين عدت لم أكن أنا نفسي كما كنت قبل أن أعيش 4 سنوات في أرض الكنانة، وبعد أن أنتهيت من دراستي الجامعية في مصر، حياتي العملية فاعلًا ثقافيًا في رابطة الكتاب الأردنيين، حين كنت أقيم بالأردن، وبدأت أكتب للصحف عن الأغنية السياسية، حيث كنت مهتما بتلك الظاهرة، ذلك الاهتمام الذي تكرس لاحقا في أول كتب يصدر لي، فسرعان ما عرفني الوسط الثقافي والنخبة في الأردن.
كيف ترى أدب المقاومة بعد جيل كنفاني ودرويش وسميح القاسم؟!
تعرض أدب المقاومة لهبوط في المكانة والدور برأيي مبكرا، منذ عام 1972، حين تأسس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، كملحق بالقيادة السياسية، قيادة "م ت ف"، وبذلك تحوّل أدب المقاومة باتجاه أن يكون الأدب الفدائي ملازما للثورة ،نعم لكن ليس المبشر بها أو المبادر لها، كما كان حال أدب المقاومة، والملازم للسياسي لدرجة أنه ظهر مثقف الفصيل.
ولأن الكتاب الفلسطينيين من جيليْ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قد عاشوا خارج الوسط الشعبي، ثم وبسبب من احتكاكهم بالمحيط العربي، أكثر من احتكاكهم بالعدو، فقد كان أن ظهرت "ردود" شعرية خاصة على شعر المقاومة، بنظم قصيدة النثر، والشعر الذاتي، وما إلى ذلك، لكن بالمقابل بدأ أدب المقاومة يظهر بنسخة أخرى، من المناطق المحتلة عام 1967، حيث ظهرت سحر خليفة وعلي الخليلي وكثيرون من الأدباء، وظل هذا الحال، في ظل قيادة "تتبقرط" بشكل حثيث، فظل درويش والقاسم يستحوذان ويصران على أدب المقاومة المتحرر من حسابات السلطة، لكن لا بد من ملاحظة أن التراجع، وأنا طبعا أوافقك بأن أدب المقاومة انكمش وتراجع في تأثيره وحضوره، لم يكن لسبب ذاتي فقط، ولم يكن فلسطينيا ايضا، ففي عصر النظام العالمي الأمريكي، باتت حركات التحرر بلا سند كوني، لكن المقاومة، ومنها انتفاضة الحجارة، مثلا، التي أثرّت في الأدب العربي كله، تنتج أدب مقاومة لكن بشكل متقطع، وبأنماط مختلفة عن ذي قبل.
كيفت تعامل النقد مع أعمالك؟
معظم النقد الذي تعرضت له أعمالي الأدبية والفنية، كان نقدا إعلاميا، وبعضه كان أكاديميا، وكان موزعا بين أكثر من بلد، وأظن أن تنقلي من بلد لآخر، أثّر سلبا في هذا الجانب، فمن جهة ما إن اعرف في بلد مثل الأردن، سوريا، مصر، حتى أغادره إلى بلد آخر، ثم لأني كتبت أكثر من لون إبداعي، فكنت كل فترة أهتم بجنس أدبي ما، بدأت طبعا بعد كتابي الأول عن الأغنية السياسية بالرواية، ثم القصة القصيرة، فالمسرحية، وما بين هذه وتلك كنت أكتب في النقد والصحافة، ثم أعود للرواية والمسرحية وأخيرا الشعر.
مع ذلك فإن الاهتمام بأعمالي كان له وجهان: الأول من خلال الكتابة النقدية عنها، حيث تعرضت كلها دون استثناء: الروايات والقصص والمسرحيات إلى النقد وبعضها إلى الترجمة، حيث ترجمت لي روايتان ومجموعة قصصية ومجموعة شعرية إلى الانجليزية ونشرت في أمريكا وألمانيا، والوجه الثاني من خلال إجراء المقابلات الصحفية معي، حيث أظن أني واحد من أكثر الكتاب الفلسطينيين من أبناء جيلي الذين أجريت معهم المقابلات الصحفية، إن كانت تلك الورقية أو الإذاعية أو التلفزية أو حتى الالكترونية، لذا ونظرا لأني اعتبر أن درجة تفاعل النص الإبداعي تعبّر عن قيمته، فإني أفردت واحدا من أعمالي الكاملة ليتضمن ما كتب عن رواياتي وقصصي من مقالات ودراسات نقدية من قبل الآخرين، من نقاد وكتاب وطلاب دراسات عليا ومهتمين.
هناك مدرستان في العنوان الإبداعي.. الأولى ترى وضعه قبل العمل والأخرى بعده.. إلى أي مدرسة ينتمي أبو سرية؟
طبعا أكتب النص أولا، فالنص مثل المولود، نسميه بعد أن يولد، ولأن العنوان يحدد ملامح النص ويعبر عن محتواه، وأظنني أتأنى كثيرا في حسم أمري فيما يخص العنوان، وعادة ما أكون أمام أكثر من خيار، أظل مترددا حتى اللحظة الأخيرة وهي لحظة الدفع بالنص للطباعة، مع ذلك أعتقد بأن علاقة العنوان بالعمل، هي علاقة متداخلة، مثل الرأس والجسد، أولا أظن بأن تحديد كنيه وشكل وحتى محتوى العمل الإبداعي مختلف من جنس أدبي لآخر.
أنا أعرف ما أقول بهذا الشأن، لأني كتبت القصة والرواية والقصيدة والمسرحية، المهم أن الفكرة بالنسبة لي أولا، ومن ثم تحديد مقولة العمل، وبالنسبة لي العمل الإبداعي ليس مناسبة للتعبير عما يجول بداخلي فقط، بل هو مهمة، لا بد أن أقول من خلالها ما ينفع الناس في الأرض، طبعا كتابة الرواية والمسرحية تأخذ وقتا طويلا، أكون خلاله أفكر في العنوان، أما القصيدة أو القصة، فغالبا ما تنجز في ليلة واحدة، لكن ما أنا واثق منه هو أني لا أضع العنوان أولا، وكثيرا ما أضطر لنشر العمل دون أن أكون مقتنعا تماما بعنوانه، مع أني معروف بأني بارع في اختيار العناوين، لدرجة أني أفكر، حين أعيد نشر بعض أعمالي، بما في ذلك الروايات، في تغيير بعض عناوينها، لأني أظن بأن العنوان يجب أن يعبّر عن كنه النص تماما وبشكل كامل. "بالمكتوب كما يقولون يقرأ من عنوانه"، العنوان يقرأ أولا، لكن ليس بالضرورة أن يكتب أولا.
بما أنك تعيش في مصر منذ زمن.. كيف ترى كتابات ما بعد 25 يناير؟
الكتابات المصرية بعد يناير في مصر مأخوذة بالكم أكثر من الكيف، حيث يبدو أن مبدعي هذه الأيام، في عجلة من أمرهم كثيرًا، لا يدققون بالشكل الكافي، والبعض لا يعطي حتى نصه حقه، فسرعان ما يشرع بكتابة ما بعده، ربما قبل أن يمنح الوقت للنص الذي انتهى منه لتوّه، ليكمل دورته مع القراء والوسط الثقافي.
وهكذا لا تبدو هناك فوارق كبيرة بين ما اطّلع عليه من نصوص، هذا يعبر عن حالة عامة بتقديري، حين ظن الناس بأن التغيير في منظومة المجتمع يتم ويكتمل بمجرد إسقاط نظام حكم سياسي، يناير منح الشباب جرأة وشجاعة، لكن ما بعده هناك حسابات جديدة ومختلفة لدى الكتاب، لذا ألاحظ بأن هناك حالة ارتداد ذاتي، في مواضيع تلك الكتابات، التي انتقلت بمعظمها من الميدان إلى داخل الذات لتنكفيء وتتقوقع، حتى التجمعات باتت عبارة عن مجموعات، وهذا شكل من أشكال الإحباط، يظهر بوضوح أكثر، ربما في الأعمال الفنية، من أغانٍ وأفلام ومسلسلات أكثر من النصوص الأدبية، مع ذلك فإن روح يناير أطلقت ألسنة الناس، بحيث صار التعبير ممكنًا لدى الجميع، وصارت المهمة منوطة بالكل وليس بالنخبة فقط، لذا نشاهد بأن الكتابة صارت فعلا شعبيا أكثر منها فعل نخبة مثقفة.
حدثنا عن تفاصيل الأعمال الكاملة التي بدأت في الظهور؟
أن أتحدث عن تفاصيل أعمالي الكاملة، وهي حصيلة فعل ونشاط وكتابة، امتدت لنحو أربعة عقود، أمر صعب جدا من خلال هذه العجالة، لكن بشكل مختصر وعام، أقول بأنها تتضمن نحو عشرة مجلدات أو كتب، بعضها سيكون في أكثر من جزء، وتتضمن: القصص، المسرحيات، الروايات، الشعر، النقد الأدبي، الدراسات، المقالات المختارة، متفرقات سردية، المقابلات الصحفية، المقالات النقدية في أدب أبي سرية، والأعمال المترجمة.
لو أصبح رجب أبو سرية وزيرًا لثقافة.. ماذا سيفعل؟
لن يكون بمقدرتي أن أفعل الكثير، لأن الوزير محكوم ببرنامج حكومي مكبل باتفاقيات، وبمنهج سياسي، ومقيدة بإرث بيروقراطي عمره ربع قرن، وفي الحقيقة، واجهت أنا شخصيا مثل هذا الاحتمال قبل أكثر من عشر سنوات، حين بادرت عام 2009 إلى تجاوز حالة الانقسام، وأدخلت قطاع غزة ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية في ذلك العام، واعتمدت سياسة فتح الباب أمام جميع المثقفين والمؤسسات الثقافية للمشاركة وأخذ حصتها من ميزانية الفعالية المركزية.
كذلك قمت بقيادة النشاط طوال العام، من خلال الشراكة بين المؤسسات الثقافية والفصائل السياسية، لأني اعتقد دائما بأن الميدان هو الفيصل، فالناس تختلف وهي جالسة على الكراسي، لكن العمل على الأرض هو الذي يكشف الحقيقي من المزيف. ولو كنت الآن وزير الثقافة الفلسطيني، لفعلت الشيء ذاته، وما اكتفيت بالعمل النخبوي أو البيروقراطي، بل كنت أفتح الأبواب أمام جميع منتجي الثقافة الوطنية في فلسطين والخارج، على قاعدة من وحدة الثقافة المتجاوزة للانقسام السياسي وللخلاف السياسي، ولكنت أهتم بالمهرجانات والورش ولرفعت شعار "أن المؤسسة الرسمية مكلفة بإقامة البنية التحتية من أجل ثقافة فلسطينية فاعلة"، وذلك يعني تشييد المراكز والقصور الثقافية، في كل المحافظات، وبناء المسارح ودور السينما ومعاهد الموسيقى والفن التشكيلي، ولأرسلت الشباب الموهوبين في منح لدراسة فنون الكتابة والفنون جميعها، إلى الخارج.
والأهم كنت أقوم بكل من شأنه أن يوحد أشتات الثقافة الفلسطينية، ولنزعت من عقل السلطة السياسية فكرة أن الثقافة الفلسطينية هي ثقافة "الدولة بحدود عام 67"، ووضعت مكانها، فكرة أن الثقافة الفلسطينية، ليست ثقافة الدولة بل هي ثقافة الوطن، لأن الثقافة الفلسطينية بلا حدود جغرافية ولا فواصل سياسية، تشمل كل المثقفين الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه، ولا تتوقف عند حدود الانتماء السياسي لها.
هناك وسائل عديدة ومتعمدة لطمس التراث الفلسطيني.. هل من حلول تجاه هذه المسألة وكيف يمكن مواجهتها؟
التراث الفلسطيني واحد من أهم أدوات الصراع على الهوية بين الشعب الفلسطيني وعدوه الصهيوني، وهنا الشعب يدافع عن تراثه بأظافره وأسنانه، وهو مجال خارج حسبة السياسة وتقلباتها، وحتى انتكاساتها، ولقد احتفظ الشعب الفلسطيني بتراثه، أي بهويته قبل أن تظهر قياداته السياسية، ولا أحد يمكنه أن يفرض عليه، تغيير عادته أو تقاليده. والتراث الشعبي متجذر جدا في الثقافة والحياة الشعبية، لذا فهو الضمانة الأكيدة والمؤكدة على أن فلسطين لن تكون لغير أهلها في نهاية مطاف الصراع السياسي.
لكن مع ذلك هناك فعاليات مُساعدة، لا بد أن تقوم بها المؤسسة الرسمية، من عقد مهرجانات التراث الدائمة والمستمرة، ودعم مؤسسات التراث، وتشجيع العاملين في هذا المجال بشتى السبل، خاصة وأن نصف الشعب الفلسطيني خارج وطنه، فنصفه الذي بالوطن يواجه إجراءات "التهويد"، وفي الخارج يواجه أيضا مغريات التوطين، وفي الحقيقة أهم ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع، هو أن الهدف يجب أن لا يكون مجرد الاحتفال بتراثنا الشعبي، كما لو كان فلكلور ظهر فيما مضى من وقت، بل أن يكون الهدف هو إحياؤه ليكون التراث فاعلا ثقافيا مقيما بين الناس، من خلال تشجيع الغناء الشعبي مثلا، عبر تحديث اللحن والكلمات، وبتحديث الزي الفلسطيني، وباعتبار العادات والتقاليد فعلا وطنيا، وبتسليط الضوء الإعلامي على كل ما في لوحة التراث من جمال، وتوزيع تفاصيلها في كل أنحاء الوطن وحيث تكون التجمعات الفلسطينية في الخارج.
من أكثر الذين تأثر بهم رجب أبو سرية في مسيرته؟
أنا أرى في كل جهد أدبي أو فني عملا ايجابيا، وفي كل نص أو أغنية أو فيلم أو مسرحية قدرا من الجمال، فيما أظن بالمقابل، بأن الكمال لله وحده، لذا فإن دائرة من قرأت لهم ومن شاهدت أعمالهم وحتى من عشقتهم كثيرة، وقد اتسعت الدائرة لتشمل مبدعين فلسطينيين، وعرب وعالميين، كنت مولعا أول حياتي بالشعر، فعشقت درويش وأحببت نزار قباني، وأظنهما أكثر من أثرّ في لغتي، وفي نظم الإيقاع الداخلي عندي، كذلك تأثرت جدا بغسان كنفاني وتجربته المتنوعة وجملته الشعبية وانحيازه الوطني، كما أني تأثرت بتكنيك جبرا إبراهيم جبرا في كتابة الرواية، كذلك تأثرت بالمغربي الطاهر بن جلون في تناول الموضوع، وتشكلت ذاكرتي وذائقتي من أدب أمريكا اللاتينية، والأدب الروسي، إضافة إلى عالم نجيب محفوظ الشعبي وقصص يحيى الطاهر عبد الله وحتى بهاء طاهر، لذا فأنا جمعت بين النص الشعبي والنص المحترف، فكانت التوليفة هي السهل الممتنع، وأنا شخص مزاجي إلى حد ما، كاره للملل، وللرتابة، ولا أحب أن أبقى على نمط أو شكل أو حتى أسلوب واحد، وأظن بأن أهم ما في العمل الأدبي هو مقولته وهي بالتالي التي تحدد لغته وتكنيكه، فلا اللغة ولا التكنيك ولا الشكل هو المقصود بحد ذاته.
أنت كاتب وناقد.. ألا ترى أن النقد والتعمق فيه أحيانًا يكون قيدًا على الإبداع؟
هذا يكون صحيحا لو كنت كاتبا أو ناقدا محترفا، أولا جل كتابنا ومعظم نقادنا الفلسطينيين والعرب هم هواة أكثر منهم محترفين، إلا بالطبع من ان يمارس النقد الأكاديمي بسبب من كونه أستاذا جامعيا، أنا مارست النقد الإعلامي، ليس الأكاديمي، ثم كمهتم، وكقارئ، فالكاتب لا بد أن يقرأ أكثر مما يكتب.
وأظن أن الأمر يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين، فأن تلم بالإطار العام للنقد يعني بأن تدرك مكنونات النص ومفاتيح عملية الإبداع، الإبداع الذي يجب أن لا يكون عفويا، خاصة فيما يخص الرواية أو المسرحية، هل يمكن أن تكتب مسرحية دون أن تطّلع على بعض من تدريب الممثل، أو ما يخص الحركة أو التمثيل، أن تتابع ما يكتب من نصوص روائية وما يكتبه النقاد يعني أن تعرف "سر المهنة"، صحيح نحن هواة، لكن ليس بشكل تام، والكتابة الإبداعية اليوم باتت جزءا من ورشة إبداعية، وليست فعلا ذهنيا منعزلا عما يحيط بك، ثم أنا أتابع كل ما يخص الثقافة من إبداع ونقد كإنسان أولا، يرغب في أن يعرف ما يدور حوله.
لذا أوافقك في الشق الثاني من السؤال وهو الخاص بالتعمق في النقد، فكونك تستهدف الاحتراف فذلك يعني أن تدرك كل شيء خاص بمجال تخصصك، أما أن تتابع فقط، فالأمر لا يتطلب هذا، ثم إني وأنا تلميذ غسان كنفاني منذ عقود ليست الثقافة عندي فعلا ذاتيا، وهي ليست مشروعا شخصيا، بل هي واجبي تجاه قضيتي الوطنية، وأنا حين أكتب عن نصوص الآخرين أظنني أحتفي بها، فأقوم بواجبي تجاهها، كما أتوقع أن يقوم الآخرون بواجبهم تجاه نصوصي، والحقيقة المؤسية هنا، أننا عشنا في زمن كان يجد نفسه المثقف العضوي الملتزم مضطرا لأن يفعل كل شيء، وما زلت أظن بأن من يريد أن يتحرر من سطوة مؤسسة السلطة أو مؤسسة القطاع الخاص، سيجد نفسه مضطرا لأن يفعل كل شيء كما لو كان "مؤسسة مستقلة" وحده أو بحد ذاته.
كيف ترى ظاهرة التوسع في الكتابات التاريخية خاصة الروايات مؤخرا؟
كتابة الرواية التاريخية ظهرت مبكرًا، ونحن قرأنا جورجي زيدان مثلا، ربما كان هناك إدراك بأن التاريخ يكتبه المنتصرون، وكل ما قرأناه من تاريخنا كان تاريخ الحكام، لذا فإن الرواية التاريخية حاولت أن تعيد الاعتبار للناس، للمواطنين، صناع التاريخ الحقيقيين.
والرواية في كل العالم كانت أداة دفاع عن الشعوب، اليوم أتسع كثيرا نطاق كتابة الرواية، وبعد أن كان يكتبها عشرات من الكتاب في كل بلد عربي، صار يكتبها المئات، لذا لم يبق موضوع لم تكتب فيه رواية ما، ولعل ما في التاريخ من ظواهر تغري الكتابة كما فعلت الدراما التلفزيونية منذ سنوات، حيث اكتشفنا بأن هناك صفحات كثيرة مشرقة من تاريخنا كعرب، لذا فإن إعادة تقديمها وكتابتها تعتبر ردا على هبوط مستوى اللحظة الراهنة.
أظن أن الراوية التاريخية كذلك تحافظ على الذاكرة، مع ملاحظة أن الأجيال الشابة، تقطع صلتها بالماضي، ولا تأخذ منه لا العبرة ولا الهوية، وكذلك كتابة التاريخ تنطوي على حقائق ثابتة، وهذا يسهل تبعات التوقع لدى بعض الكتاب، وبتقديري ليس المهم هو شكل الكتابة، بل مضمونها ومحتواها، لأن حادثة أو واقعة تاريخية يمكن أن تقرأ بأكثر من قراءة، حسب رؤية الكاتب، لهذا فإن البعض تناول الرواية التاريخية من زاوية توفير عنصر الإندهاش، فنجد أنها أخرجت جملة أعمال تلفزيونية سميت بالفنتازيا التاريخية، قدّم من خلالها جماليات ما هو غير مألوف على الصعيد البصري، وهرب من تبعات التدقيق في التاريخ، لأن قراءة التاريخ أيضا تحتمل قدرا من التأويل الذي يتطلب جهدا مضاعفا، ويدخلك إلى أتون الجدل والمعارك.