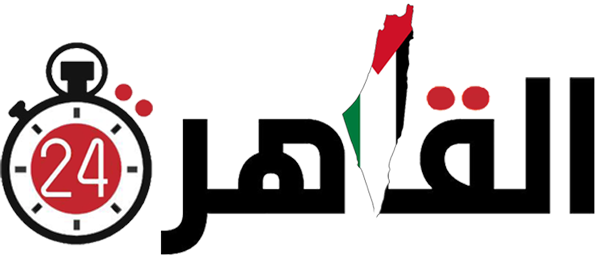جراح الذاكرة لا تلتئم.. أجساد أطفال سوريا وليبيا والعراق منقوشة بألوان الحزن والحرب | شهادات حية

وسط المدافع والصواريخ والأسلحة الفتّاكة والتعرُّض للخطف والتهجير القسري وفقدان الأهل والأصدقاء؛ فقدَ الأطفال الذين عاشوا سنوات عجافًا مع النزاعات والحروب، طفولتهم وأحلامهم ومستقبلهم، متذكرين أحداثًا مؤلمة لا يمكن نسيانها مع مرور الوقت.
ولا يمكن تصور معاناة أطفال الحروب، حيث إنهم ليسوا محاصرين فقط في مرمى النيران أو يعاملهم المقاتلون والمجتمع والجماعات المسلحة على أنهم أضرار جانبية قابلة للاستهلاك، ولكنهم غالبًا ما يكونوا مستهدفين بشكل متعمدٍ ومنهجي، إذ تم قتلهم وتشويههم واغتصابهم وقصفت مدارسهم ومنازلهم.. كل ذلك أثر في مستقبلهم وتفكيرهم وثقافتهم وصحتهم النفسية.
القاهرة 24 تواصل مع أشخاص عاشوا حالة الحرب في دول: سوريا والعراق وليبيا (الأكثر تأثرًا بالنزاعات)، متحدثين عن طفولتهم التي فقدوها وذكرياتهم الأليمة التي عاشوها، من فَقدٍ لأهل وأصدقاء ومعلمين؛ حتى باتوا لا يعرفون كثيرًا عن العالم الخارجي، ولا يدركون حقيقة أخرى غير حقيقة الحرب والتهجير، وعرفوا معنى الغربة والتهجير وقسوة الحياة.
مريم العراقية.. طفلة عاشت التهجير مرتين ورأت جثث الأطفال
البداية من العراق الذي شاهد أحداثًا جسيمة شابت لها الولدان، وهذا ما حدث مع مريم البياتي التي تعرضت للتهجير مرتين، مرة في أثناء احتلال العراق عام 2003 والأخرى فترة الحرب الأهلية العراقية الأولى (2006-2008)، بالإضافة إلى حرب داعش على العراق عام 2014.
صاحبة الـ21 عامًا كانت فترة طفولتها صعبةً للغاية؛ فحينها كنت تقيم في بغداد المنصور بمنطقة الكرادة الشرقية ولا تنسى - حتى هذه اللحظة - صوت الانفجار والقصف الجوي وصافرات الإنذار جراء الاحتلال الأمريكي الذي أثّر في حياتها على جميع المستويات.

لم أنسَ خوف أمي عليّ خلال هذه الفترة التي كان سني حينها 4 سنوات وانتقلنا إلى مكان آخر داخل بغداد؛ تاركين البيت الذي عِشنا فيه وسيارة والديّ ومدرستي الأفلاذ الابتدائية، ومكثنا في المكان الجديد الذي لم أتعوّد عليه، ومن ثم انتقلنا إلى محافظة أخرى، وخلال رحلتنا حدث انفجار وقصف جوي بالطائرات الأمريكية؛ ما أدّى إلى قطع الطريق حتى دخلنا إلى بيتٍ كي نحتمي فيه من هذه الأحداث المؤلمة.. هكذا تحدثت مريم.
ومرّت أشهر على مريم (تحديدًا في عمر الخامسة) حتى عادت إلى بيتها القديم في بغداد المنصور وبدأت حياتها من الصفر، فلم تجد صديقاتها اللواتي تعوَّدت عليهن، ولا تعرف عنهن أي شيء حتى الآن؛ لدرجة أنه توَّلد بداخلها إحساس الخوف من فَقدِ أي شخص خاصةً الأب والأخ.
أخشى صوت سيارة الإسعاف
وخلال هذه الفترة لا يخلو يوم من الأيام من الانفجار والقصف والتهديدات المستمرة؛ حتى سيطر الخوف على مريم وتوقفت حينها عن التعلُّم، ووصفت هذه الأحداث قائلة: في الوقت الذي يذهب أبي إلى العمل كان الخوف يسيطر عليّ خوفًا من فقدانه وعدم عودته إلى البيت، متابعة: حتى هذه اللحظة لا يترك صوت الانفجار خَاطري؛ حتى إنني أخشى صوت سيارة الإسعاف رغم كِبر سِني، ففي الوقت الذي تعوَّدت على صوت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والقتلى والجثث، باتت لديّ رهبة من هذا الصوت الذي يتعلق بكل ما له علاقة بالدمار والانفجار والألم.
وتحكي مريم: انتقلنا بعدها إلى محافظة صلاح الدين بمنطقة تكريت وعِشنا فترة صعبة لعدم التأقلم خلالها ولكنها كانت أكثر أمانًا من العاصمة بغداد التي ترددتُ عليها خلال هذه الفترة، وتعرضنا للقصف ورآنا المسلحين والمليشيات المسلحة حتى تعودنا على وجودهم ووجوههم، ففي إحدى المرات بعد انتهاء اليوم الدراسي في مدرسة (متوسطة عتبة بن غزوان للبنات) حدث انفجار بالقُرب من مدرسة أخي (ثانوية عمر المختار للبنين)، وذهبتُ لأطمئنُ عليه من شدة خوفي.
وبعد أحداث عام 2008 ذهبت مريم وأسرتها إلى سوريا (تحديدًا في دمشق شارع خالد بن الوليد) مُهجرين ثم عادوا إلى العراق متنقلين بين تكريت وبغداد، وتتذكر خلال هذه الفترة أنه وقعت انفجارات واُستشهد على إثرها كثير من الأطفال والطلاب، مؤكدة: أصبحنا نمرُّ على جثثهم وعِشنا حالة من الرعب والخوف، وحينها توفي كثير من العراقيين داخل بيوتهم من شدة الانفجار، وهذه الانفجارات ظلت عالقة في ذهني ولم أنساها حتى وقتنا الحاضر، ولا أنسى مشهد بكاء الأمهات عندما رأين أطفالهن قتلى وجثثًا؛ متابعة: بعد هذه التفجيرات في عام 2009 لم نستطع العيش في بغداد فقررنا الرحيل إلى مدينة أخرى.
حرب داعش.. حينما أصبح الأطفال رِيَاجِيل
وعن الحرب الأهلية العراقية عام 2014 - التي بدأت على شكل حركة تمرد ثم تصاعدت وتيرة الأحداث لتتحول في نهاية المطاف إلى حرب عسكرية طويلة الأمد مع تنظيم إرهابي مسلح يأكل الأخضر واليابس ولا يرحم طفلًا ولا مسنًا ولا شيخًا ولا امرأةً؛ تقول مريم: في أثناء حرب داعش كنتُ في محافظة صلاح الدين بمدينة تكريت وعندما رأينا هذه الجماعات كُنا نطلق عليهم لقب المسلحين؛ فلم نعلم حينها هويتهم أو انتماءاتهم أو ولاءهم.
وبسبب هذه الأوضاع انتقلت البياتي إلى بغداد ورأت في أثناء التنقل شخصًا يُفجّر نفسه، وحينها تعوَّدتُ على هذا المشهد خاصة أنه دارت معارك طاحنة بين الجيش العراقي وتنظيم داعش الذي كان يهاجم الجميع جيسًا وشرطةً وشعبًا، وفي إحدى المرات حدثت انفجارات ومواجهات عسكرية بين الجيش وداعش بمحافظة صلاح الدين، وتلقت نبأ استشهاد أصدقاء أبيها الذين كانت تعرفهم جميعًا ويعاملونها معاملةً حسنةً، وحينها أصاب الذعر والحزن.

باختصار شديد لم نعش طفولتنا التي كُنا نرغبُ فيها لدرجة أن الأطفال الصغار أصبحوا رِيَاجِيل (تعني رجالًا باللهجة العراقية) أي يقومون على حاجة البيت وأهله ويربون أخواتهم الصغار، متسائلة: هل مكتوب على العراقيين أين يعيشوا هذا المصير منذ سنوات؟ لماذا لا أعيش في استقرار وأمن وأمان؟!
البياتي اختتمت حديثها - والحزن يملأ قلبها وخاطرها وصوتها - بأن الشباب العراقي أكثر فئة تأثرًا بما حدث، فلم يجرب مثل هذه الأحداث المؤلمة، إذ استيقظ فجأةً على قصف الطائرات والصواريخ والحشود المنظمة من الجيوش والجماعات؛ ما أدَّى إلى ضياع آمالهم وطموحاتهم في ظل الخوف والقلق وانتظار الموت في أي لحظة؛ لذلك نجد داخل كل عراقي حزنًا كبيرًا؛ حتى بات الشباب العراقي في حالة من العزلة الشديدة، لما رأوه من أحداث جسيمة.
حكاية شاب عراقي مع غزو العراق وحرب داعش
وفي مدينة الكاظمية عام 1994 وُلد محمد حسين الشمري الذي لم يكن يعرف أنه سيواجه في المستقبل مصيرًا مؤلمًا مليئًا بالتفجيرات والقصف والقتلى وحياةً صعبةً لا يقدر على تحمُّلِها، وعلى الرغم من أن الحياة قبل احتلال العراق عام 2003 لم تكن على ما يرام اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن الطفل ذا التسع سنوات تبدّل حاله من طفل لا يهمه أي شيء إلا اللعب والذهاب إلى مدرسته (مدرسة صدام حسين) إلى طفل كل ما يتمناه هو سلامة أهله وأخوته الخمسة.
وفي العشرين من مارس عام 2003 احتلت أمريكا العراق وأصبح الشمري خائفًا من أداء الامتحانات، إلا أن والده نصحه بأدائها، وقد كان فقد أداه وسط حالة من الهلع والخوف الشديدينِ، وبعد مرورها على خير، بلغ السيل الزُبى، وانقلبت حياته رأسًا على عقب، ورأى ما لم يرغب في رؤيته أبدًا.
حزام ناسف داخل المقهى
منذ أن كنت صغيرًا أعشق نادي اي سي ميلان الإيطالي، وفي أحد الأيام ذهبتُ إلى المقهى لحضور إحدى مباريات ميلان مع أصدقائي وخلال مشاهدتنا المباراة دخل علينا رجل يبكي ويصرخ - دون سبب مفهوم - وفجأة انفجر حزام ناسف؛ ولكن من حُسن الحظ أنني كنتُ في آخر المقهى على الرغم من الرعب الذي عِشته، فإنني صُدمتُ من مشهد الجثث المرعب.. هكذا يحكي الشمري.
وحكى محمد موقفًا آخر قائلًا: في مرحلة الثانوية ودون سبب سمعتُ صوتَ مدير المدرسة يصرخُ قائلًا: اخرجوا من المدرسة من الباب الخلفي، وبالنسبة ليّ كان هذا الشيء غريبًا ومفاجئًا، وتركت حينها حقيبتي من شدة الخوف، وعلمتُ بعدها أنه كانت هناك سيارة مفخخة بالقرب من باب المدرسة.
التعرض للخطف ووفاة ابن العم
ولم تكتفِ حينها الأحداث المتسارعة في العراق بعد احتلالها بهذا القدر من القسوة، بل تعرَّض الشمري للخطف، متذكرًا هذا الموقف بحزنٍ شديد ساردًا إياه: في عام 2008 كنت أتجولُ في أزقة بغداد القديمة، وتفاجأت بمسلحين ملثمين يرفعون السلاح في وجهي وأخذوني ووضعوني في الحقيبة الخلفية للسيارة وفجأة وجدتُ نفسي في مكان أشبه بالسرداب، وبعدها بقليل أتى رجل وسأل عني واتضح أنني لم أكن الشخص المراد، وبعدها رموني في مكانٍ عشوائي في الشارع، ثم ذهبتُ متجولًا في شوارع بغداد حتى رجعت إلى المنزل.
وبعد عام 2008 بدأ الوضع الأمني يتحسن تدريجيًا، حتى جاءت العواقب الوخيمة التي لا تحمد عقباها، إذ سقطت أربع محافظات عراقية بيد تنظيم داعش الإرهابي (الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك)، بالإضافة إلى نحو نصف مساحة محافظة ديالى وأطراف من بغداد وذلك خلال صيف عام 2014.
وعن هذه الأيام العصيبة يقول الشمري: خلال إحدى ليالي شهر رمضان في بيت جدي بدأت تسقط قذائف على مدينة الكاظمية في بغداد وسقطت إحدى قذائف الهاونات على حديقة بيت جدي، وتوفي على إثر ذلك ابن عمي البالغ من العمر 13 سنة، وفي أثناء عملية القصف قررنا الخروج من المنزل؛ مضطرين في حيرةٍ من أمرِنا، وفي نهايةِ الأمر توجهنا إلى مكان عشيرتنا (القبيلة) في جنوب مدينة بابل العراقية.
5 مدارس مختلفة في المرحلة الابتدائية.. قصة فتاة سورية عاشت التهجير
وسط مدينة معضمية الشام بريف دمشق - تحديدًا بالغوطة الغربية - عاشت (ش. م) طفولةً رائعةً وسط المنطقة المعروفة بجمالها في ظل جو من الألفة والمحبة والتعاون بين جميع سكان المدينة - كما تصورها المسلسلات والدراما السورية - ولا تزال الصورة الذهنية القديمة خلال فترة طفولتها محفورةً في مخيلتها حتى الآن، فكان هناك جو مليء بالأمان داخل الحارة السورية قبل اندلاع الثورة.
وفي منتصف شهر مارس عام 2011 بدأت شرارة الثورة السورية، وعاشت صاحبة الـ11 سنة آنذاك حياةً مختلفةً عن ذي قبل، إذ فقدَتْ كثيرًا من الأصدقاء والأقارب، وانتقلتْ فقط إلى خمس مدارس خلال المرحلة الابتدائية، وانقطعت اجتماعيًا عن العالم خاصةً أقاربها الذين تربتْ معهم منذ الطفولة، وتوّلد لديها الخجل والخوفُ، ففي الوقت الذي تعوَّدت على الأصدقاء والجيران فجأةً تتركهم وترحل إلى مكان آخر.

وفي بداية عام 2013 انتقلت الفتاة السورية إلى منطقة أخرى وذهبت إلى المدرسة في الصف السادس الابتدائي، وعلى الرغم من الأمان الذي عاشته في هذه البلدة، فإن هناك نوعًا من عدم الشعور بالأمان الداخلي، وحالة من الشرود النفسي والذهني؛ حتى توَّلد لديها شعور بأنها في أقرب وقت ستتعرض للقتل أو بيتها سيتم قصفه أو تتعرض للخطف أو ستذهب إلى المدرسة ولن تعود مجددًا.
وتروي الفتاة عن الحياة القاسية التي عاشتها بعد عمر العشر سنوات: عِشنا أحداثًا من المفترض كطفلة لا أعيشها حتى فترة الأعياد التي ينتظرُها أي طفل، إذ قدمنا ثلاثة شهداء (أولاد عمي) في العائلة وفقيدًا وهو عمي الذي لا نعلم عنه أي شيء حتى الآن، حيث توفي ابن عمي في أثناء التهجير واُستشهد آخر من خلال إحدى رصاصات القناصة لتنظيم داعش واستشهد أيضًا الثالث برصاصة غدرًا من هذه الجماعة المسلحة وأتذكر حينها - بعد فقدِ التواصل معه - أننا علمنا بالخبر عن طريق فيسبوك، حيث أكد فاعل خير وجود جثة ولا يعلم هُويتها، كما تعرَّض أولاد خالتي الأربعة إلى الاستشهاد في مجزرة جماعية، بالإضافة إلى تعرض بعض أفراد عائلتي للتهجير القسري.

لم أكن أعرف ماذا تعني كلمة مظاهرة!
وتقول الفتاة: حتى وقتنا هذا لم أرَ المعلمين والأساتذة الذين علموني وأصدقائي الذين تعرضوا للفقد أو القتل، ولم أرَهم حتى الآن، وعن عائلتي قبل عام 2013 كان التهجير والانتقال جماعيًا، ولكن مع مرور الوقت بعد عام 2015 حدث تفكك أسري، وانفصل جميع أفراد الأسرة (العائلة الكبيرة) عن بعضهم.

ونظرًا لقُربها من العاصمة السورية، فإنها عاصرت كثيرًا من الأحداث، وكحال الجميع كانت تهتم بمتابعة الأخبار والأحداث المتسارعة بعد الثورة السورية؛ حتى اقتربت المظاهرات وأعمال العنف من مدينتها، إذ وجدتْ حشودًا من الناس يتظاهرون بعد الخروج من المدرسة (الخامسة الابتدائية للبنات)، وحينها لم تكن تعرف ماذا تعني كلمة مظاهرة، ولم ترَها في التلفاز من قبل.
وشعرت حينها بأنَّ هناك شيئًا حماسيًا يجمع هؤلاء المتظاهرين أو ربما هناك شيء مختلف لم تتعود عليه، حتى اكتملت الصورة لديها بعد مرور الوقت واعتادت على كلمة المظاهرة والتجمعات، وأصبحت رؤية تجمعات الشرطة والمتظاهرين أمرًا اعتياديًا.
طريق المدرسة محفوف بالمخاطر.. لماذا يموت هؤلاء الناس؟
وعلى الرغم من قُرب المدرسة فإن أهلي كانوا يشعرون بخوف شديدٍ عليّ جراء الأحداث المتسارعة غير المتوقعة وبات التوتر والخوف ينتقل إلى الأطفال وبعدما كان الطريق إلى المدرسة أسهل طريق تعوّدنا عليه، بات أكثر رعبًا نتيجة المظاهرات والاحتجاجات، وتحوَّل الأمر من حشود وتجمعات سليمة إلى مناوشات مسلحةٍ تُذهق فيه الأرواح من المدنيين وقوات الشرطة السورية، ولم أستوعبُ وقتها ماذا يحدث حوليّ وبدأت أتساءلُ لماذا يموت هؤلاء الناس؟.. هكذا تحكي الفتاة.

وعن هذه الأحداث التي رأتها، تقول الفتاة السورية: تحولت الأمور وتغير المشهد بعد أيام، حيث قُطع الطريق إلى المدرسة، وبات المكان محاصرًا من الشرطة وقُطت الكهرباء ووسائل التواصل المتاحة بشكل تدريجي، ففي الوقت الذي تعوّدتَ عليه من طعام بعينه أو اللعب مع الجيران والأصدقاء تحوَّل هذا الأمر فجأة، لدرجة أننا انقطعنا عن المدرسة لمدة تصل إلى أشهر في بعض الأحيان؛ لذلك تأثر مستواي الدراسي، وفي محاولة مِنا لمحاولة استمرار الدراسة والوصول بسلامٍ إلى المدرسة، كُنا نذهب إليها عن طريق مجموعات؛ حتى نكون أكثر أمانًا وسط طلقات النيران.
استشهاد مديرة مدرسة وآثار دم تغطي المكان
وتتابع: مع مرور الوقت فقدتُ أصدقائي بالمدرسة عبر التهجير أو القتل أو الفقد أو السفر دون معرفة أي معلومات عنهم، غير أن مديرة المدرسة التي كنتُ فيها تعرضت للقتل عبر قذيفة، لذلك فإنَّ هذه الأمور لا يمكن نسيانها وظلَّت عالقة في ذهني، ولن تذهبَ عن خاطري، فبعد فترةٍ أصبح القتلُ بشكل أكبر بين المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة؛ حتى رأيتُ اشتباكات ومناوشاتٍ أمام عيني، ولا أنسى في إحدى المرات في شهر رمضان الكريم جثة طفل لأحد الجيران أمام البيت كان مخطوفًا وقُتل ووُضع أمام بيوتنا في الحارة؛ حتى تعلق بذهني وذهن الجيران ومَن حولنا، أنَّ كلَّ يوم بعد فطار رمضان سيحدث شيء ما.

وفي إحدى المرات في أثناء الذهاب إلى مدرستها تقول الفتاة: رأيتُ طفلة تعرَّضت للقتل أمام عيني وظلَّ مشهد آثار الدم في مخيلتي، ففي هذا الوقت كنتُ أذهب إلى المدرسة لإتمام الامتحانات بالصف الخامس الابتدائي، ثم أعودُ إلى بيت آخر قريبٍ من المدرسة خوفًا من التعرض لأي أذى، متابعةً: فجأة تأزمت الأوضاع وسمعنا ممّن حولنا يقولون إنه سيتم قذف المدراس، وتعوَّدنا على صافرات الإنذار، وحينها ذهبنا إلى مكان أبعد من المدرسة والبيت بريف دمشق، في منطقة بها بساتين وحدائق فقط، وتُعد شبه مقطوعة ولا تصل إليها أي وسيلة مواصلات ولا توجد أي خدمات لشراء الطعام، وهي بلدة الدروشا أو الدروشة التابعة لمنطقة قطنا في محافظة ريف دمشق.
وعن الفترة التي قضتها في بلدة الدروشا تقول: انتقلتُ إلى هناك وذهبتُ إلى مدرسة لم أتعود عليها حتى اللهجة كانت مختلفة، وبعدها بشهرين انتقلتُ إلى منطقة أخرى تسمى خان الشيح، ودخلتُ إلى المدرسة في هذه البلدة؛ ولكنها تعرَّضت للقصف على الرغم من ارتياحي فيها وتعوّدي عليها، وخلال هذه الفترة التي قضيتها في بلدة خان الشيخ أصبحَ القصف والخطر أكثر اقترابًا مني ومن أهلي.
لم أنسَ أصدقائي المفقودين وتمنيتُ الموت
شكَّلت مدينة سرت الساحلية محورًا للصراع بين جميع الأطراف المقاتلة بعد اندلاع الثورة الليبية، حيث إنها مسقط رأس الزعيم الراحل معمر القذافي ومعقل تنظيم داعش في بداية يونيو 2015، ومحور نزاع بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق؛ وذلك لموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب.
وفي خضم هذه الأحداث الليبية ووسط طلقات النيران المنهمرة على سكان المدينة كالمطر، عاش وسام علي الهمالي ظروفًا قاسية، إذ سقط صاروخ من نوع راجمة أمام بيته وأصيبت أمه بشظية في يدها، لذلك قرر الرحيل مع أسرته الصغيرة المكونة من أربعة أفراد.

وعن هذه الأيام يقول الشاب ذو الـ23 عامًا: للحرب كثير من الذكريات التي لم أستطع نسيانها، وظلت ذاكرتها في قلبي منذ الصغر حتى يومنا هذا، وأتذكر تلك الأيام كأنها اليوم، ولم أنسَ الأصدقاء الذين فقدتهم في الحرب، ولم أنسَ تلك المعاناة التي عِشنها، حيث تعرض الأطفال والعائلات للقصف.
وقد جعلت هذه الأحداث ومشاهد القتلى والدمار ورؤية الجثث من طفل - كلُّ همه اللعب مع الأصدقاء والذهاب إلى المدرسة (مدرسة الزعفران في مدينة سرت) - إلى طفل يحاول الانتقام ممن تسببوا في تهجيره وتدمير مستقبله، وهذا ما حدث مع الهمالي وأخيه.
وعن هذه الأيام الصعاب يقول وسام: في إحدى المرات جاء أخي وقالي لي سوف أذهب لكي أحارب (رد بالك من أمي وأختي) وذهب وعند غروب الشمس عاد أخي وكان هناك شخص يحمله قائلًا لقد أصيب بطلقة من قناص.. ولا تخافوا هو بصحة جيدة.

وتابع: لقد أصابت إحدى الطلقات أخي في جانبه وخرجت من الجانب الآخر، ولم تكن هناك مستشفيات لأن المدينة محاصرة حينها، ولم يتوقف أخي عن النزيف، حتى بحثنا عن ممرض، وخيّط الجرح له وعالجه، وفي هذا اليوم لم أذق طعم النوم، فكان صوت الرصاص لا يتوقف أبدًا.
وفي الساعة الحادية عشرة ليلًا سقط صاروخ ودمر إحدى السيارات وكانت سيارة محملة بالذخيرة بجوار المنزل، حتى اشتعلت النيران ودخلت للمنزل، مؤكدًا: وقتها أتذكر النيران مشتعلة وسط كر وفر من النساء والأطفال، وحينها تمنيت الموت من أجل الراحة من هذه المعاناة، ولكن شاء القدر وأنقذني رجل وأخرجني من المنزل الذي رحلنا منه إلى منزل آخر، وفق راوية الهمالي.
ويقول الهمالي: تعرض كثير من الأشخاص الذين أعرفهم للقتل في الحرب، ففي الشارع الذي أسكنه فيه اُستشهد فيه سبعة أشخاص بقصف عشوائي من حلف الناتو، وهناك أشخاص فقدوا أطرافهم بسبب مخلفات الحرب، بعيدًا عن انتشار الأوبئة والأمراض جراء مخلفات الحروب.
ويسرد: تعرض منزلنا للقصف وتضرر كثيرًا وفي أثناء التهجير ضرب عناصر تنظيم داعش خالي وابنه أمامنا وكانت النساء تبكي وهم يضحكون وقبضوا على ابن خالي ووضعوا السكين على رقبته؛ لكي يرهبونا، حتى ذهبنا إلى إحدى الضواحي القريبة من المدينة، تاركينَ جيرانا ومنزلنا المنهار وأصدقاءنا.
وكان يعيش في مدينة سرت 120 ألف شخص، لكن عددًا منهم فروا خلال الثورة عام 2011 أو بعد سيطرة تنظيم داعش عليها في 2015، ولا يزال هناك نحو 50 ألف مدني في المدينة، وقد اُعتقل القذافي وقُتل على مقربة من سرت في أكتوبر 2011، بعد أن استُهدف موكبه بغارة جوية شنَّها تحالف تقوده فرنسا وبريطانيا وأمريكا، وبعد عام 2011، تُركت سرت التي باتت رمزًا للنظام السابق، لمصيرها في بلد على شفير الهاوية، إذ استغل تنظيم داعش الفوضى ليجعل من سرت معقله الرئيسي في ليبيا، وفي يونيو 2015، باتت راية داعش السوداء ترفرف على أبنية حكومية في المدينة، حيث قُطعت أيادٍ ورؤوس في الساحات أمام أعين الناس.
وبصوت مليء بالحزن والأسى يتذكر الطالب في جامعة سرت معاناته خلال فترة الطفولة: كانت أمي تعد لنا الفطور عن طريق التنور وكنا نشعل النار في الصباح الباكر؛ لأن هناك صواريخ حرارية، ولا نستطيع إشعال النار في الليل حتى لا نتعرض للقصف، وتعرضنا للتهجير في عام 2011، وفي حرب داعش 2015 خرج جميع سكان المدينة بسبب سيطرة داعش عليها بعد تم تسليمها لهم، ووصل بهم الأمر إلى الصلب وقطع الأعناق.
عندما يذهب الأطفال للقتال بحثًا عن المال
وفي هذا الصدد، يقول كامل الكعبي الصحفي العراقي: لقد عانى الأطفال العراقيون معاناة كبيرة نفسيًا واجتماعيًا جراء كثرة الحروب، حيث وُلدوا من رحم معاناتها وأثرت تراكمات الماضي فيهم، ففي فترة بين عام 2011 والسنوات التي تلته كان البلد في أوج الحرب الطائفية التي راح ضحيتها كثير من الأطفال، متابعًا: لم يستطع كثير من الأطفال إكمال دراسته لأسباب عدة منها أمنية وأخرى اقتصادية، ومنهم من بقي حبيسي الجدران بالبيوت أو يعملون بمهن لا تلائم أعمارهم ونفسياتهم.
ويرى الكعبي أن أغلب الأطفال العراقيين باتوا لا يملكون الثقافة والدراية بالمتغيرات التي طالت العالم، فأصبح همهم الوحيد توفير لقمة الخبز لعوائلهم وما يحتاجون، ومن ثم تزوج كثير منهم في سن مبكرة وزادوا الطين بلةً من كثرة معاناتهم وهمومهم المتعاقبة، بحيث لم يتمتعوا بطفولتهم حالهم حال أقرانهم في المجتمعات المختلفة من حيث الدراسة والعناية الطبية، وأصبحت فرص العمل قليلة جدًا، وذهب كثير منهم للقوات الأمنية لإيجاد فرصة للعمل تضمن لهم مستقبلًا.
ويؤكد: المعاناة كبيرة ومؤسفة من حيث العمق والأسى والألم النفسي والذهني للأطفال العراقيين من كثرة ما مرَّ عليهم وعلى أهلهم من الحروب المتعاقبة والويلات، ما أدَّى لوجود كثير من حالات الطلاق والقتل والمشكلات الأسرية والنفسية داخل المجتمع العراقي؛ نتيجة ما عانوه طيلة الفترة الماضية؛ حتى توَّلد لديهم إحساس بأن المستقبل بات مجهولًا في ظل المناكفات والمشكلات السياسية وعدم الاستقرار على جميع المستويات.
منظر الدم أمر معتاد لدى الأطفال السوريين
أما وصال شحود، الكاتبة السورية والناشطة في مجال دراسات وأبحاث ورعاية ذوي الإعاقة، فترى أنه من المؤكد أن الحروب عامةً تؤثر في الطفولة التأثير الأكبر؛ لذلك فإنَّ أطفال سوريا يعانون أشد أنواع قساوة الظروف منذ بداية الأحداث في سوريا، حيث فقد كثير منهم أهاليهم أو عددًا من أفراد عائلتهم، وبدأت رحلة الفقدان تتوالى، حيث فقد الأطفال مساكنهم ومدارسهم وأصدقاءهم وشوارعهم بل فقدوا أوطانهم وعرفوا معنى الغربة والتهجير وقسوة الحياة.
وتابعت رئيس مجلس إدارة مجلة أسينات ومدير العلاقات الخارجية للجمعية العامة للبحوث والتكنولوجيا: لا ذنب للأطفال إلا أنهم وُجدوا في هذا التوقيت من الزمن وفي هذه الظروف؛ لذلك فقدوا الأمن والأمان وعانوا الجوع والفقر المدقع والحرمان والدفء؛ ما أدَّى إلى تحطيمهم نفسيًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى تخلفهم عن رَكب العلم والمعرفة لكونهم فقدوا مدارسهم، مؤكدة أن الجانب الأخطر هو مواجهتهم حالات العنف والدمار والقتل، فقد بات منظر الدم أمرًا معتادًا لديهم، وشهدوا القصف والتفجير وكلَّ الأمور التي تبعد عن الإنسانية وتضع حقوق الطفل في حياة غير آمنة.
غريزة القتل ونزعة القوة.. الطفل الليبي يفرغ شحنة غضبه بإطلاق النيران
ويرى الدكتور بجامعة سرت الليبية عبد الله محمد أطبيقة أن الأطفال الليبيين عانوا منذ عام 2011 خاصة ما يتعلق بالتهجير من مدينة لأخرى لا سيما مدينة تاورغاء التي هُجر سكانها لمدة 10 سنوات وأصبح أطفالها مشردين، وانتقلت العائلات من مدينة لمدينة أخرى، بالإضافة إلى مدينة سرت التي دُمرت في عام 2011 وضُربت بجميع أنواع الأسلحة وضربت أيضًا في عام 2015 في أثناء حرب تنظيم داعش على ليبيا.
غير أنَّ انتشار الأسلحة سبَّب أزمة كبيرة للمجتمع خاصة الأطفال الذين انضموا إلى الجماعات والتشكيلات المسلحة وتدربوا على استخدامها؛ لدرجة أن الطفل يفرغ شحنة غضبه على هيئة إطلاق النيران نحو الآخرين؛ حتى أصبح الأطفال قتلة محترفين دون معرفة تداعيات وخطورة هذا الأمر على استقرار الأوضاع في البلاد، وفق رأي أطبيقة.
ويتابع: عانى الأطفال من حالة العزلة حتى أصبحوا انطوائيين ولا يختلطون كثيرًا بالآخرين، فمسألة الخوف لديهم زادت حدتها وأصبح البعض لديه غريزة القتل ونزعة القوة وبات لدى البعض الآخر نوع من البرود عند رؤية الدماء تسيل أمام أعينه أو رؤية الأشخاص قتلى دون أن يتحرك ساكنًا.
وعن التأثير السلبي الاجتماعي يقول: هجرة العائلات من مدينة إلى أخرى أو قرية إلى قرية أو عدم الاستقرار بشكل عام اجتماعيًا والتعرف على شخصيات جُدد في حياة الأطفال أو حالة عدم استمرار الأصدقاء وتغيير المحيطين به بشكل مستمر، وذلك يحدث في أثناء التهجير من مدينة الطفل والعودة مرة أخرى إلى مدينته ولا يجد أصدقاءه القدامى الذين تعوّد عليهم.. كل ذلك له تأثر نفسي عميق.
وبناءً على ما تقدم، فإنه يمكننا الجزم بأن أطفال الحروب في أي مكان في العالم تأثروا بتداعياتها على جميع المستويات، لذلك إنْ لم يتلقوا الدعم النفسي الذي يحتاجونه، فسيكون من الصعب إصلاح الضرر، حيث إنهم يحتاجون إلى الدعم بما في ذلك التمويل الكافي للصحة العقلية والبرامج النفسية والاجتماعية والاقتصادية.